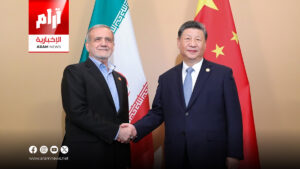تعرف على حركة الفتوة في التاريخ الإسلامي.. الخليفة الناصر والسلطان بيبرس أبرز أعضائها واعتُبرت شبيهة التنظيم بـ”الإخوان”

روى المؤرخ تقي الدين المقريزي (ت 845هـ/1441م) -في كتابه ‘السلوك لمعرفة دول الملوك‘- أن السلطان الظاهر بيبرس (ت 676هـ/1277م) بعد أن فرغ من صلاة عيد الفطر سنة 659هـ/1261م جلس في خيمته، وحضر إليه أول الخلفاء العباسيين في مصر المستنصر بالله الثاني (ت 660هـ/1262م) فـ”ألبسه سراويل الفتوة بحضرة الأكابر”، وكانت من يد الخليفة مباشرة؛ وبذلك جمع الظاهر بين السلطنة والفتوة وأصبح من “أهل الفتوة” وعضوا في “جماعة الفتيان”.
إن هذا المشهد يعكس عدة دلالات لعل أهمها شعبية تلك الحركات، وهو ما بدا في حرص سلطان قوي مثل بيبرس على أن يتدثر بلبوسهم، ويتزيّا بزيهم بكل ما يمثله من معنى في مخيلة ووجدان المجتمع. وحتى نفهم الفتوة يجب أن نفهم الآليات المنتِجة للجماعات والتنظيمات التي يتشكل فيها الآحاد من الأمة الإسلامية، فالحياة داخل الحضارة الإسلامية لا تستقيم إلا عبر جماعة ووحدات انتماء اجتماعية قد تكون قبلية أو طُرُقية أو طائفية أو مذهبية… إلخ.
وعلى جدران كل انتماء ووحدة ترتسم وفرة من المفاهيم والقِيَم تضبط مساره وتنظم عمله وتحدد موضعه. والجماعة لا تنشأ إلا لطلب ولا تحضر إلا تلبية لحالة تستدعيها، وليس هناك من حاجة أشد من الفراغ السياسي وضعف سلطة الحكم، حيث يزداد الطلب على الانتماء المعزِّز ويكثر الإلحاح على حضور الجماعات المناصرة والتنظيمات المؤازِرة.
وهذا القانون ينطبق تمام الانطباق على جماعات الفتوة التي كان أكثر ما يميزها أنها جمعت بين قيمتين هامتين: الأمانة والقوة. ومردّ هذا الجمع هو حاجة المجتمع إلى ذلك الدمج الخلّاق بين هاتين القيمتين بعد أن عانى انفصاما خطيرا بينهما، وجزء من حضور الفتوة هو نجاحها في تجسيد ذلك الدمج في تشكيلات اجتماعية بعد أن فشلت السلطة السياسية في معادلة ذلك الجمع.
ولذلك نلاحظ أن الفتوة -في جوهرها- تقوم ببعض الوظائف السياسية الاجتماعية؛ مثل الحراسة والتأمين، وردع المتخاصمين، ورد الحقوق، ومواجهة الحركات الهدامة، وتحمل أعباء الغير، والفدائية، والمساعدة والإغاثة، وكلها كانت سجايا اعتاد الفرد العربي أن يجدها في قبيلته، ثم انتقلت إلى الفرد “القوي الأمين” إزاء جماعته وأمته.
وظهور الفتوة بهذا الشكل التطوري من الجاهلية إلى الإسلام -بحسب ما ترصده هذه المقالة- يكشف لنا كيف كان يتحوّر القديم ويتطور الجديد في أروقة الحضارة الاسلامية، فكل ذلك ما كان يتم إلا باستكشاف الذات؛ فالفتوة لها أصل جاهلي قَبَلي حسّنه الإسلام وحرر مفهومه وضبط توظيفاته ليكون في خدمة الإيمان لا العصبية، ثم تحرك هذا المفهوم داخل الحركة الصوفية -بعد نشأتها- فغرق في بحورها التربوية، ثم انفصل عنها لظروف شتى ليتميز في سياقات متعددة وأطُر متنوعة، فكانت جماعات الفتوة التي ربطت بين أرجاء العالم الإسلامي شرقا وغربا، بل وكان لها أثر كبير في نقل تراث الفروسية الفتيانية إلى الحضارة الغربية.
ليس هذا فحسب؛ بل إن هذه المقالة تدعم الرأي الذي يرى أن نشأة بعض التيارات الإسلامية المعاصرة -مثل جماعة الإخوان المسلمين- هو امتداد لذلك الفكر التنظيمي الحركي التراثي، وأن نشأة التيارات الإسلامية لم تكن استنساخا لتجارب الحركات الشيوعية والفاشية كما يراه البعض، وإنما هي احتذاء أمين لأثر ذلك الموروث الحضاري العربي الإسلامي بعد أن تم تطويره بتطعيمه بما يلائمه من تجارب الأمم الأخرى.
ولذلك فإن هذه المقالة تضع أمامها جملة أسئلة تسعى للإجابة عنها عبر استنطاق مدونة النصوص التاريخية المتعلقة بموضوعها، أسئلة من قبيل: ما هي “الفتوة”؟ وكيف برزت في الوجود العربي؟ وهل كانت مستعارة من ثقافات أخرى أم نجمت من داخل الثقافة العربية؟ وكيف نفهم الأثر الذي أحدثته في العالم الإسلامي؟ وما هي أشد لحظاتها سطوعا؟ وكيف كانت تنشأ الحركات المجتمعية في الحضارة الإسلامية وما طبيعة الفكر الحركي داخلها؟ وكيف انتقلت روحها إلى الثقافة والتقاليد المجتمعية الأوروبية؟ وهل لها من امتدادات في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم؟
ميراث أصيل
بالعودة إلى مواريث البادية العربية في جاهليتها؛ يمكن أن نلمح عدة صفات حميدة تندرج في دلالات مفردة “الفتوة” عند العرب واتّصف بها قطاع كبير منهم، وكلها تدور حول معاني الفروسية والشجاعة والمدافعة والكرم، وقد وصفوا بالفتوة الشاب السخي المقدام قال أبو بكر الرازي (ت بعد 666هـ/1268م) في ‘مختار الصحاح‘: “الفتى..: السخي الكريم، يقال: هو فتًى بيّنُ الفتوة”. ولعل من أقدم النصوص التي أجّجت هذا المعنى وسجلته بيت الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد (ت 569م):
إذا القوم قالوا: من فتًى؟ خِلتُ أنني عُنيتُ فلم أكسل ولم أتبلّد
فطرفة هنا يرى أنه المعني الأول بمواجهة الصعاب والشدائد، وهنا يتضح أن الفتوة كان لها عند عرب الجاهلية محتوى قيمي داخلي وعلامة بدنية رياضية، وهذا الجمع بين رياضة البدن والإيثار والتضحية من أجل الآخرين هو ما يشكل الأرضية التي يرتكز عليه خُلق الفتوة.
وتقترب الفتوة في دلالاتها من “المروءة”، وإن كان ابن القيم (ت 751هـ/1350م) يذهب –في ‘مدارج السالكين‘- إلى أن المروءة أعم منها، ولذلك يقول اللغويون إن “المروءةَ الإنسانيةُ”. أما أبو الرَّيْحان البِيرُوني (ت 440هـ/1049م) فيرى –في كتابه ‘الجماهر في معرفة الجواهر‘- أن “المروءة تقتصر على الرجل في نفسه وذويه وحاله، والفتوة تتعداه.. إلى غيره”.
ويبدو أن البِيرُوني يلمّح هنا إلى الأثر الذي أدخله الإسلام في الثقافة العربية، حين جعل النخوة والتضحية متجاوزة لخدمة القبيلة إلى خدمة الأخوة الإيمانية. فالفتى عند البِيرُوني “هو الذي اشتهر بالقدرة عليها (= تحمُّل أعباء الآخرين)، وعُرف بالحِلم، والعفو، والرزانة والاحتمال، والتعظم والتواضع؛ [فبذلك] يرقى إلى العلياء”.
وهكذا تحرك المفهوم مع مجيء الإسلام لينتقل من التمركز العصبي إلى وصف لطبقة ممتازة من المؤمنين، يجعلون من الفتوة منهجا تدريبيا لتربية النفس، وإعدادها للصعاب والتضحية والفدائية والفروسية، إذ اندمجت تلك القيم ضمن إطار الأخلاق الإسلامية وكانت ظاهرة في ميدان الحروب التي خاضها المسلمون في بداية الدعوة، فوُصفوا حينها بأنهم “رهبان بالليل وفرسان بالنهار”؛ كما قال القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت 415هـ/1025م) في ‘تثبيت دلائل النبوة‘.
لكن هذه الفتوة بدأت -مع الأيام- تتبلور حولها جملة من المعاني الروحية التي تعبر عن اتجاه في التصوف، فحاول بعض المتصوفة أن يجعل منها قيمة روحية صِرْفَة، بينما رأى آخرون من غيرهم أن يكتفي بجانبها المادي البدني فقط، كما نجد لدى حركات الشطار والعيارين و”نبلاء اللصوص”.
الفتوة الروحية
قلنا إن فكرة الفتوة تمركزت عند بعض الصوفية حول معنى جهاد النفس، باعتباره أوْلى من جهاد العدو الخارجي، فتمسكوا بالمصطلح لكنهم تحركوا به نحو ما يمكن أن نسميه “المغامرة الروحية”، وقرروا الاستعانة بالفروسية من أجل سلوك طريق الإيمان الصعب. وفي ذلك يقول الراغب الأصفهاني (ت 502هـ/1108م) في ‘الذريعة إلى مكارم الشريعة‘: “وقد استعارت الصوفية لفظ الفتوة للتصوف لكونها مشاركة له في جميع أفعالها إلا في الغَرَض، فإن غرض الفتيان استجلابُ محمدة الأقران، وغرض المتصوفة استجلابُ محمدة الرحمن، بل مجرد مرضاته تعالى”.
وهنا نرى الشريف الجُرْجاني (ت 816هـ/1413م) -في كتابه ‘التعريفات‘- يعرّف الفتوة انطلاقا من المزاوجة بين دلالتها اللغوية الأصلية ومفهومها الصوفي الطارئ؛ فيقول إن “الفتوة في اللغة: الكرم والسخاء، وفي اصطلاح أهل الحقيقة هي: أن تؤثِر الخلق على نفسك بالدنيا والآخرة”.
وقد أفرد أبو القاسم القُشَيْري (ت 465هـ/1074م) بابا في ‘الرسالة القشيرية‘ للحديث عن الفتوة، أورد فيه أقوالا عن حقيقتها يدور معظمها حول الروح الإيثارية الإيمانية، ومنها قوله إن “أصل الفتوة أن يكون العبد أبدا في أمر غيره قال ﷺ: لا يزال الله تعالى في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه المسلم”. وينقل عن الفضيل بن عياض (ت 187هـ/803م) أن “الفتوةَ الصفحُ عن عثرات الإخوان”.
وأما شيخ الصوفية الحارث المُحاسبي (ت 243هـ/857م) فعنده أن “الفتوة أن تُنصِف ولا تَنتَصِف”. ويقول الحافظ ابن عبد البر الأندلسي (ت 463هـ/1071م) –في ‘بهجة المجالس‘- إنه “ذُكِرتْ الفتوة عند سفيان (الثوري المتوفى 161هـ/779م) رحمه الله، فقال: ليست بالفسق ولا الفجور، ولكن الفتوة كما قال جعفر بن محمد (= الإمام جعفر الصادق المتوفى 148هـ/766م): طعام موضوع، وحجاب مرفوع، ونائل (= عطاء) مبذول، وبِشْر مقبول، وعفاف معروف، وأذى مكفوف”.
واستدعى القشيري روح “المغامرة” الإيمانية والتحدي من الإمام أبي القاسم النَّصْرَآباذي (ت 367هـ/978م) الذي يقول: “سُمي أصحاب الكهف فتية، لأنهم آمنوا بالله تعالى بلا واسطة، وقيل: الفتى من كسر الصنم، قال الله تعالى: ﴿سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾، (سورة الأنبياء/الآية: 60) وقال تعالى: ﴿فَجَعَلَهُم جُذَاذاً﴾ (سورة الأنبياء/الآية: 58)، وصنمُ كل إنسان نفسُه؛ فمن خالف هواه فهو فتى على الحقيقة”. وهنا نلاحظ اقتصار روح المواجهة الإبراهيمية على شكلها الداخلي دون تحدي سلطة الملِك النمروذ، واختصار الأصنام المتجسدة في الحياة في صنم النفس أو الهوى.
الفتوة العابثة
لم تكن أخلاق الفتوة مما اختصّ به ثقافة وممارسة الرجال دون النساء؛ فقد جاء في كتاب ‘مفيد العلوم ومبيد الهموم‘ المنسوب لأبي بكر الخوارزمي (ت 383هـ/994م) أن “امرأة بنيسابور حملت زوجها إلى القاضي تدعي عليه خمسمئة دينار فأنكر الرجل، فاستدعى القاضي منها إحضار الشهود فأحضرتهم، فقالوا حتى نكشف عن وجهها ثم نشهد! فهمّت ]المرأة[ أن تسفر عن وجهها فصاح الرجل وأدركته الغيرة، وقال أنتم تريدون أن تنظروا إلى وجه زوجتي؟! أيها القاضي أشهد أن لها عليّ حقا واجبا ستمئة دينار؛ فتعجب القاضي والحاضرون من حميته وغيرته، فقالت المرأة: أيها القاضي أشهدك أنه بريء من حقي وأني قد أحللته من ذلك؛ فتعجبوا غاية العجب!!
ثم قال القاضي: اكتبوه وضعوه في باب الفتوة”!! وأورد الإمام شمس الدين الذهبي (ت 748هـ/1347م) –في ‘تاريخ الإسلام‘- راوية تتحدث عما يمكن تسميته “فتوات النساء”، فقد قال في ترجمة أحمد بن خِضْرَوَيْهِ البَلْخي الزاهد (ت 240هـ/854م) إنه “من جِلّة مشايخ خراسان، سألته امرأته أن يحملها إلى أبي يزيد (البَسْطامي المتوفى 264هـ/878م) وتبرّئه من مهرها، ففعل. فلما قعدت بين يديه (= البسطامي) كشفت عن وجهها، وكانت موسرة فأنفقت مالها عليهما. فلما أراد (= البلخي) أن يرجع قال لأبي يزيد: أوصني. قال: ارجع فتعلم الفتوة من امرأتك”!!
كانت الفتوة في بعض مراحلها شديدة الروحية وفي بعض آخر شديدة المادية، بحيث “انقلبت الشطارة في المواقف المشرفة إلى شطارة وعيارة في فتوة مزيفة، فالشراب والألعاب والغناء والتشطُّر والإرهاب صارت من صفات الفتوة الثانية اللاهية”؛ كما يقول الدكتور مصطفى جواد (ت 1389هـ/1969م) في مقدمته لـ‘كتاب الفتوة‘ لابن المعمار البغدادي الحنبلي (ت 642هـ/1244م).
فنحن نجد لدى هذه الفئة من أصحاب الفتوة –التي تسمى ‘العيارين‘- قواعد أخلاقية ذات صلة بالشهامة والنبل، لكنها -في نفس الوقت- تقوم بأعمال سرقة وترويع. وقد انتقدها على ذلك ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) -في ‘تلبيس إبليس‘- فقال: “ومن هذا الفن تلبيسه على ‘العيارين‘ في أخذ أموال الناس؛ فإنهم يسمَّوْن بالفتيان، ويقولون: الفتى لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحرم ولا يهتك ستر امرأة، ومع هذا لا يتحاشون من أخذ أموال الناس، وينسون تقلي الأكباد على الأموال، ويسمون طريقتهم الفتوة”!
لكن عند استقراء بعض فترات التاريخ الإسلامي نجد أنه جرت محاولات لإرساء تصالح بين الفتوة الدينية ونظيرتها البدنية، ولعل أُولى هذه المحاولات نضجا تلك التي ارتبطت بمرحلة ضعف الدولة الإسلامية عندما شاعت اللصوصية والاعتداء على الحرمات، وخاصة حين خلع إبراهيم بن المهدي (ت 224هـ/839م) طاعة ابن أخيه الخليفة المأمون (ت 218هـ/833م) سنة 202هـ/817م، رغم أن جراح بغداد وما حولها لم تندمل بعدُ من الحرب الأهلية بين المأمون وأخيه الأمين (ت 198هـ/814م).
فتن بغداد
ففي تلك الأيام وقع هرج ومرج كبير ببغداد سمح بظهور جماعات “الفتوة اللاهية”، فانطلقت أيدي اللصوص تعيث فسادا في المدن والقرى، وهو ما يصوره الطبري (ت 310هـ/922م) بقوله -في تاريخه- إن “الشطار -الذين كانوا ببغداد والكرخ- آذوا الناس أذى شديدا، وأظهروا الفسق وقطع الطريق، وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق…، وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر أن يمتنع عليهم…، لأن السلطان كان يعتز بهم وكانوا بطانته، فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يركبونه”.
وهنا مسّت الحاجة لإعادة اللُّحمة المجتمعية بمواجهة تلك الحركة العبثية الفوضوية، فشرع البعض في محاولة استعادة ميراث الفتوة الحقيقية بعد يأس من حماية السلطة، فتشكلت لجان شعبية لحماية حرمات المدنيين، و”قام صلحاء كل رَبَضٍ (= حي سكني) وكل دَرْبٍ (= شارع)، فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما في الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة، وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم، فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحدا لقمعتم هؤلاء”.
وقد تزعم أمرَ هذه اللجان -في البداية- رجلٌ من منطقة الأنبار غربي العراق اسمه خالد الدريوش (ت بعد 202هـ/817م)، قال الطبري إنه ظهر ببغداد سنة 201هـ/816م “فدعا جيرانه وأهل بيته وأهل محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأجابوه إلى ذلك، وشد على من يليه من الفساق والشطار فمنعهم مما كانوا يصنعون، فامتنعوا عليه وأرادوا قتاله فقاتلهم فهزمهم، وأخذ بعضهم فضربهم وحبسهم ورفعهم إلى السلطان”. لقد اعتبر الدريوش أن حركته جزء من الضبط الاجتماعي وليست حركة معارضة تسعى للقفز على السلطة، ولذلك “كان لا يرى أن يغيّر على السلطان شيئا”.
ويضيف الطبري أنه بعد ذلك بأيام برز ببغداد أيضا رجل آخر “يقال له سهل بن سلامة الأنصاري (ت بعد 202هـ/817م) من أهل خراسان..، فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله جل وعز وسنة نبيه ﷺ، وعلّق مصحفا في عنقه، ثم بدأ بجيرانه وأهل محلته فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه، ثم دعا الناس جميعا إلى ذلك…، وجعل له ديوانا (= سِجِل تنظيمي) يثبت فيه اسم من أتاه منهم، فبايعه على ذلك، وقتال من خالفه وخالف ما دعا إليه كائنا من كان، فأتاه خلق كثير فبايعوا، ثم إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ومنع كل من يخفر ويجبي المارة”.
وهنا حدث اللقاء بين الفروسية -أو الفتوة الشعبية- وبين القيمة الدينية متجلية في حركة خالد الدريوش زعيم الحرافيش، وسهل الأنصاري الذي يريد أن يقدم محتوى ثوريا دينيا لتلك الحركة الشعبية؛ فقال له الدريوش إنه لا يضمر موقفا من السلطة القائمة وإنما هدفه سدُّ الثغر الأمني والخرق الاجتماعي. أو بعبارته هو: “أنا لا أعيب على السلطان شيئا.. ولا أقاتله ولا آمره بشيء ولا أنهاه”، فردّ عليه الأنصاري: “لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان سلطانا أو غيره، والحق قائم في الناس أجمعين، فمن بايعني على هذا قبلته، ومن خالفني قاتلته”. فجهز إبراهيم بن المهدي -بعد أن بايعه بنو العباس- جيشا لقتال سهل بن سلامة، فغلبه وأسره وانحلّ أمره سريعا.
انتشار وتوسع
بدت حركة الفتيان نموذجا لبناء تنظيمات من العمل الشبابي السري الذي يقوم على قواعد مكتوبة وأنظمة داخلية خاصة، واتصلت بهذا النموذج اتجاهات إسماعيلية وحشّاشية وحركات غنوصية، كانت كلها تناصب النظام الرسمي العداء وتتبنى مناوأته.
بل إن المؤرخ والجغرافي المسعودي (ت 346هـ/957م) يحدثنا -طبقا لما ينقله عنه المؤرخ شهاب الدين النُّوَيْري (ت 733هـ/1333م) في ‘نهاية الأَرَب في فنون الأدب’- عن وجود ظاهرة الفتوة في الصين، فيقول إنه “لم تزل أمور الصين مستقيمة في العدل على حسب ما جرى به الأمر فيما سلف من ملوكهم إلى سنة أربع وستين ومئتين [هجرية = 264هـ/878م]؛ فإنه حدث في مُلك الصين أمر زال به النظام… وكان سبب ذلك أن خارجيا (= ثائرا) خرج ببلد من مدن الصين وهو من غير بيت الملك…، وكان في ابتداء أمره يطلب الفتوة ويجتمع إليه أهل.. الشر، فلحق الملوكَ وأربابَ التدبير غفلةٌ عنه..؛ فاشتدّ أمره.. وقويت شوكته”.
وفي الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/الـ11م؛ اكتُشِف تنظيم سري لمنتسبي الفتوة في بغداد، وتفيد المعلومات -التي وثقها سبط ابن الجوزي (ت 654هـ/1256م) في كتابه ‘مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‘ عن هذا التنظيم- بأن الفتوة وصلت في ذلك العهد إلى مستوى متقدم من التنظيم والانتشار والتنظير الفكري، وهو ما يفرض مراجعة الشائع لدى الباحثين من أنها تعمقت وعُمِّمت في القرن السادس الهجري/الـ12م في عهد الخليفة العباسي الناصر بالله (ت 622هـ/1225م)، كما سيأتي بيانه.
فقد قال سبط ابن الجوزي -في كتابه السالف الذكْر- إنه “في ذي الحجة [من سنة 473هـ/م1080] قُبض ببغداد على ابن الرسولي الخبّاز (ت بعد 473هـ/1080م) وعبد القادر الهاشمي البزّاز (ت بعد 473هـ/1080م)؛ [لأنهم] انتسبوا إلى الفتوة، وكان ابن الرسولي قد صنف في الفتوة وفضلها كتابا، وذكر قوانينها ورسومها، وجعل عبد القادر المتقدمَ (= المسؤول) على من يدخل في الفتوة وأن يكونوا تلامذته، وكَتَب [بأسماء] المقدَّمين مناشر (= مناشير)، وأقطعهم أصقاعا (= أقاليم)، ولقّب نفسَه «كاتب الفتيان»، وجعل ذلك طريقا إلى منفعته ودعوات واجتماعات تعود على مصلحته”.
ويكشف سبط ابن الجوزي عن بعض الارتباطات الخارجية لهذا التنظيم وترتيبات عمله داخليا؛ فيقول: “وكَتَبَ [ابنُ الرسولي الخبّاز] إلى خادمٍ لصاحب مصر (= الخليفة الفاطمي) بمدينة النبي ﷺ يُعْرف بخالصة الملك ريحان الإسكندراني (ت بعد 473هـ/1080م) قد ندب نفسه لرياسة الفتيان، والكتبُ صادرة إليه بذلك من جميع البلدان، وجعلوا اجتماعهم بجامع بَرَاثا [ببغداد]، وكان مسدود الباب مهجورا ففتح ابنُ الرسولي بابَه ورتّب له قيِّما (= مشرفا) ينظفه”.
وقد أثار صعودُ نجم تنظيم الفتوة هذا ببغداد حفيظةَ التيار الحنبلي فيها ممثَّلا بمجموعة منه عُرفت بـ”أصحاب عبد الصمد”، واشتهرت بنشاطها الدعوي في الشارع البغدادي؛ فتحركوا لدى السلطة العباسية لوقف أنشطة هذا التنظيم وتفكيكه، وتذرعوا لذلك بإثارة رعب سلطة بغداد من أي ارتباط بين رعاياها والدولة الفاطمية بمصر والشام، فربطوا بين الفاطميين والقائمين على التنظيم باعتباره أحد التنظيمات الباطنية السرية الكثيرة التي كانت تنشرها القاهرة آنذاك في أقاليم الدولة العباسية لتقويضها فكريا وسياسيا.
وفي ذلك يقول سبط ابن الجوزي: “عَرَف «أصحابُ عبد الصمد» ذلك (= أنشطة الخبّاز والبزّاز) فأنكروه وعظّموا ما يكون منه، وقالوا: إن هؤلاء يدْعون لصاحب مصر، ويجعلون دارَ الفتوة عنوانا لجمع الكلمة على هذا الباطن (كذا؟ ولعلها: الباطل أو الباطني)، فتقدم الخليفة إلى عميد الدولة (الوزير أبو منصور ابن جَهير المتوفى 493هـ/1100م) بالقبض على ابن الرسولي وعبد القادر فقبض عليهما، ووَجد لابن الرسولي في هذا المعنى (= الدعاية للفاطميين) كتبا كثيرة إلى الخادم [الفاطمي] المقيم بالمدينة، فسأله عميد الدولة عن الموافقين له فسمّاهم، فقبض على جماعة منهم، وهرب الباقون، وصودر جماعة بسببهم”.
تسييس الفتوة
وفي حقبة لاحقة؛ يحدثنا ابن المعمار البغدادي -المتقدم ذكْره- عن الانتشار المجتمعي لهذه التنظيمات وتكاثرها، ولاسيما خلال القرنين السادس والسابع الهجرييْن/الـ12 والـ13م؛ فيقول: “لم تزل الفتوة تنتقل -هلمّ جراًّ- إلى عصرنا هذا، حتى تفرعت وصارت بيوتا وأحزابا وقبائل كالرهاصية والشحينية والخليلية والملدية والنبوية، لما حدث بينهم من الاختلاف”.
ويؤرخ ابن المعمار للحظة التي التفتت فيها الدولة العباسية -في زمن الخليفة الناصر- إلى تلك القوى الاجتماعية وقررت أن تدمجها في بنيتها الرسمية، لتوظيف قوتها الشعبية المتنامية في خدمة تقوية مركزها السياسي لدى العامة، مما يعين في ترسيخ مكانة الخليفة ويساعده على موازنة قوة السلاطين الأتراك المزاحمين له في تدبير الدولة، فوفّر الناصر الظروف الملائمة التي تدعم نشر هذا التنظيم في أقطار الخلافة بعد أن أصبح أحد أجهزة السلطة شبه العسكرية.
وبالتالي من الخطأ القول إن الفتوة ظهرت في القرن السادس الهجري/الـ12م، بل الحقيقة هي أنها سبقت عهد الناصر وإن كانت إنما وُظِّفت رسميا -على نحو أمثل- في عصره. وفي ذلك يقول ابن المعمار: “فلما انتهى ذلك إلى عصر سيدنا ومولانا الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين… أنعم نظره التام، واختار كبيرا في الفتوة [هو]: الشيخ الصالح العابد الزاهد السعيد عبد الجبار بن صالح البغدادي (ت 583هـ/1187م)”. لقد كان الشيخ عبد الجبار أشبه بـ”الشيخ عفرة” الذي قال للفتوة عاشور الناجي: “لتكنْ قوتُك في خدمة الناس لا في خدمة الشيطان”؛ وفقا لما جاء عند نجيب محفوظ (ت 1427هـ/2006م) في روايته ‘ملحمة الحرافيش‘.
استعان إذن الخلفية العباسي الناصر -وهو شاب طريّ التجربة لا يزال في السادسة والعشرين من عمره- بموجّه روحي هو الشيخ عبد الجبار البغدادي، فطلب منه أن يُلبسه “سراويل الفتوة” (= زِيّها التنظيمي الموحَّد) وأن يعطيه سندها، وذلك بمشورة وضغط من الدائرة المقربة من الخليفة نفسه لكي يستفيد من النفوذ الشعبي الكبير لتنظيم الفتوة التابع للشيخ عبد الجبار، وخاصة أنه كان حينها يسعى للتخلص نهائيا من نفوذ السلطان السلجوقي على قصر الخلافة.
ونحن نستجلي هنا أخذ الناصر للفتوة من أقدم مصدر لها؛ فمؤلفه هو ملك حماة المنصور ابن المظفر الأيوبي المتوفى سنة 617هـ/1220م، أي قبل وفاة الخليفة الناصر بست سنوات. ففي نصه الذي سنورده هنا يبدو الدافع السياسي للناصر جليا في انضمامه إلى تنظيمات الفتوة سعيا للسيطرة على فوضى حركاتها التي تعددت حينها في بغداد، واشتد التنافس بينها على كسب دعم السلطة.
بين رأييْن
إن هذا الاستعراض التاريخي لظاهرة الفتوة يشير إلى عدم دقة القول باستيراد هذه الظاهرة بشكل خامل وسلبي من ظواهر ثقافية غربية رومانية أو يونانية، أو حتى تأثرا بتجارب الجماعات الإسماعيلية والقُرْمُطِية، وذلك على نحو ما ذهب إليه المستشرق لويس ماسينيون (ت 1382هـ/1962م) ونقله عنه برنارد لويس (ت 1439هـ/2018م) في أربعة مقالات ترجمها الدكتور عبد العزيز الدُّوري (ت 1431هـ/2010م) بعنوان: “النقابات الإسلامية”؛ ونشرها -قبل نحو ثمانين سنة- في مجلة “الرسالة” المصرية ضمن أعدادها: (355-356-357-362).
ذلك أن التحليل التاريخي المستقصي العميق يصل بنا إلى أن ظاهرة التشكل الذاتي فكرةٌ أصيلة وحاضرة في الثقافة العربية الإسلامية، وأن روحها هي أثر من آثار إعادة الإنتاج الرَّحِمي القَبَلي عبر وحدات انتمائية تحقق الترابط والدعم بين المنتمين إليها بغض النظر عن أصولهم، وقد جاء هذا بتوجيه من الإسلام وبممارسة نبوية واعية تأسست أول مرة في مجتمع الرسالة خلال العهد المدني.
وبالتالي فإن الأكثر دقة من كلام هؤلاء هو القول بقدم مفهوم النقابة والتنظيمات الاجتماعية، وكذلك قدم روح وجوهر “الفتوة” التي هي فرع من التشكل الاجتماعي الذاتي، وأن ما كان يسري في عروق حركات الفتوة القويمة هو عصارات معرفية ومفاهيم دينية نابعة من صميم القيم الإسلامية.
ولعل هذا الجانب من الرصد هو ما غفلت عنه أغلبية الدراسات في مجال التأريخ للحركات الاجتماعية في الحضارة الإسلامية، ولم تتحرّ فيه على النحو المطلوب؛ إذْ لا يمكن دراسة تيارات الفتوة من خلال البناء الخارجي -الذي قد يتشابه مع أي تنظيم آخر- دون النظر إلى محتوى تعاليمها الفكرية والتربوية التي أثبتنا جذرها العربي القديم والإسلامي السُّني بحسب التحليل السابق.
أما اتخاذ تيارات الفتوة وضعا مضادا لما عُرفت به الحركات والتنظيمات السرية القُرْمُطِية وغيرها، وكذلك تبنيها إستراتيجيات مناوئة للسلطة؛ فقد جاء في سياق الجنوح لنزعة المواجهة لا على سبيل التقليد لتلك التنظيمات، ويبقى التشابه الوحيد بين الفريقين هو اشتراكهما في اللجوء إلى سلاح التحشيد الشعبي وحروب الفدائيين، وهذه أنماط من المواجهة معروفة في كل الخبرات الحضارية، بل وتلجأ إليها السلطات السياسية حينما تفشل في المواجهات النظامية مع خصومها المسلحين، ولهذا السبب التفتت السلطات العباسية -في بعض لحظات ضعفها- إلى حركات الفتوة وحاولت الاستفادة منها، وتوجيهها نحو الكفاية المطلوبة للمواجهة الشاملة مع الحركات الهدامة أو مراكز قوى ضاغطة.
ترسيم للتنظيم
يقول الملك المنصور في كتابه ‘مضمار الحقائق وسر الخلائق‘ شارحا السياق الذي أقدم فيه الخليفة الناصر على الانخراط في عضوية تنظيم الفتوة التابع للشيخ عبد الجبار البغدادي: “وفيها (= سنة 578هـ/1182م) تقدم الخليفة بإحضار جماعة من الندماء والجلساء إليه كان كثير الميل إليهم…، وفي هذه السنة اجتمع هؤلاء القوم المذكورون عند الخليفة وحسّنوا له أن يكون ‘فتى‘، وقالوا له إن هاهنا رجلا حسنا يقال له عبد الجبار خلفه خلق كثير، وهؤلاء يُحتاج إليهم”.
وهكذا تم الاتفاق بين الشيخ والخليفة على انضمامه لتنظيم فتوته، و”لبس الخليفة سراويل الفتوة..، وأنعم على الشيخ عبد الجبار بخمسمئة دينار..، ثم إن الخليفة.. كثر حديثه في هذا وحسن الأمر عنده، ولم يبق أحد ممن كان قريبا منه إلا ولبس منه سراويل [الفتوة]، وتقدم إلى أبي علي بن الدوامي (ت بعد 578هـ/1182م) أن يكون نقيب الجماعة، وأن يخطب ويذكر شروط الفتوة وأحوالها المرضية لأنها من الخصال المحمودة الشريفة”.
أصبحت الفتوة –وقد تسلحت بدعاية الدولة السياسية والإعلامية والدينية- نمطا من أنماط النبالة والفروسية بعد أن اندمجت في السلطة، فشاعت حينها ولعقود لاحقة في أماكن كثيرة من العالم، بعد أن “وردت (سنة 607هـ/1210م) رسل الخليفة الناصر لدين الله إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة، ويلبسوا لها سراويلها”؛ طبقا لما يخبرنا به ابن الوردي المَعَرِّي (ت 749هـ/1348م) في تاريخه.
ويصف الذهبي –في ‘سير أعلام النبلاء‘ اتِّساع انتشار الاستجابة لدعوة الناصر بين ملوك زمانه، فيقول إنه لما “ظهرت الفتوة… تفنّن الناس في ذلك ودخل في الأجلاء ثم الملوك، فألبِس العادل (الأيوبي ملك مصر والشام المتوفى 615هـ/1218م) وأولاده سراويل الفتوة، وشهاب الدين الغُوري (ت 602هـ/1205م) صاحب غزنة (= أفغانستان اليوم) والهند، والأتابك سعد صاحب شيراز”.
كان الهدف السياسي إذن واضحا من إحياء الفتوة وجعلها جهازا رسميا تابعا لقصر الخلافة يتولى نشرها في العالم الإسلامي، وذراعا عسكرية يعوض بها الضعف العسكري للجيش الرسمي؛ هذا فضلا عن إخضاع الأمراء والولاة لهذا النظام تحت إمرة “شيخ الفتيان الإمام الناصر” دعماً للولاء وحسماً للتبعية، “فبطلـ[ـت] الفتوة في البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويلها..، فلبس سائر ملوك الأطراف سراويلات الفتوة له”؛ حسب ابن واصل الحموي (ت 697هـ/1298م) في ‘مفرج الكروب‘.
تعاليم وطقوس
اتسم نظام الفتوة ببعض الطقوس الخاصة، باعتبارها جمعية لها “سندها المتصل” إلى علي بن أبي طالب (ت 40هـ/661م)، وهو أمر أنكر صحتَه ابن تيمية (ت 728هـ/1328م) وتقي الدين السبكي (ت 756هـ/1355م)، وذلك في فتوى لكل منهما في قضية مدى شرعية تنظيمات الفتوة. والعجيب أن سند الفتوة -الموجود لدى معتنقيها- يبدأ من علي إلى سلمان الفارسي (ت 33هـ/655م) مرورا بأبي مسلم الخراساني (ت 137هـ/755م) الذي انتهت حياته بشكل مأساوي حينما اتهِم بالتآمر على الدولة العباسية، التي تولى الدور العسكري الأكبر في تأسيسها.
ثم إن حركات الفتوة صنعت لها “تاريخا نبويا” مفارقا لتاريخ الصحابة؛ فـ”شيوخ الفتيان” هم إبراهيم عليه السلام وفتية الكهف، وكل هذه الرمزيات كان لها دورها الإيحائي والعاطفي في الحشد التنظيمي والدعاية العقدية وجذب الأنصار، وكانت تلك الأحوال العجيبة من أنماط التفكير في العصر الوسيط. وظل أمر الانضمام للفتوة متصلا في دولة المماليك حتى صار إحدى سمات الحياة المصرية الشعبية، حيث شاعت ظاهرة ‘الفتوات‘ ببعض مناطق القاهرة.
وبعد أن “أهدِرت الفتوة القديمة، وجعل أمير المؤمنين الناصر.. القِبلة في ذلك والرجوع إليه فيه” بتعبير المؤرخ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م)؛ تم توحيد خيوط حركات الفتيان، وشرع الناصر في إخضاع أتباعها للتدريبات العسكرية والبدنية بجانب الإعداد الروحي، وتم إحياء طقوس الفتوة مثل حفلات البيعة لإعلان انضمام الفتيان، فكان المنتمون للجمعيات الفتيانية يستقبلون في مقرات خاصة حيث يقسمون قسم الفتوة، ويلبسون سراويلها، ويشربون كأسا من الماء المملَّح، وينخرطون في التدريبات البدنية فيرمون بالبندق ويتسابقون في العدو ورمي النبال.
وطبقا لما يورده المستشرق الهولندي رينهارت دُوزي (ت 1300هـ/1883م) في كتابه ‘تكملة المعاجم العربية‘؛ فإنه “حين يُقبل في هذا النظام من هو جدير به يُلبسونه أمام الجمهور سراويل يسمى ‘سراويل الفتوة‘ أو لباس الفتوة، وهو رمز الفتوة والرجولية، وينتقل من الأب إلى الابن…، ثم يقدمون له كأسا يسمى ‘كأس الفتوة‘. ومن حق الفتى أن يرسم على سلاحه صورة الكأس (وكان هذا هو الذي يفعلونه غالبا) أو صورة السراويل، أو صورة الكأس وصورة السراويل معاً.
والقَسَم الذي يقسمه عضو الفتوة من أكثر الأقسام قدسية”. ويقول المستشرق الألماني فرانز تيشنر (ت 1387هـ/1967م) في بحثه ‘الفتوة والخليفة الناصر‘ المنشور ضمن كتاب ‘المنتقى من دراسات المستشرقين‘: “شاركت نقابات الفتوة في الجهاد وفي مقاتلة الكفار والهراطقة، فكنت تجدهم على حدود المملكة الإسلامية وفيما وراء النهر.. وعلى ثغور الجزيرة والشام، وكان لهم نصيب في المنازعات الداخلية في الإسلام أيضا”.
ومن أمثلة ذلك مشاركة جماعات الفتيان في المناوشات الطائفية بين الشيعة والسنة؛ يقول ابن جبير في رحلته بعد ذكره لانتشار الشيعة في بعض مناطق الشام: “وسلّط الله على هذه الرافضة طائفة تُعرف بالنبوية، سُنيّون يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها. وكل من ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه منها يحزمونه السراويل فيلحقونه بهم…، وإذا أقسم أحدهم بالفتوة بَرَّ قَسَمَه…، وشأنهم عجيب في الأنفة والائتلاف”!!
انعكاسات معاصرة
ومن المثير للدهشة أن هذه الحركة الفتيانية كانت تقوم على مبدأ المساواة الاجتماعية بين منتسبيها؛ يقول ابن المعمار: “أما الذكور فصنفان أيضا: عبيد وأحرار وهما في الفتوة سواء”، كما سمح نظام الفتوة بانضمام المسيحيين واليهود، وإن كانت مرتبهم ظلت أقل شأنا داخل التنظيم من نظرائهم المسلمين”؛ وفقا لما أورده المستشرق تيشنر.
وكانت للفتيان تسمياتهم ورموزهم التنظيمية الخاصة وأحصى ابن المعمار –في كتابه ‘الفتوة‘- 24 لفظة تدل على أفكار ورتب تنظيمية داخلية مثل “البيت والحزب والكبير”، ومن اللافت فيها أنهم كانوا يطلقون لقب ‘الرفيق‘ للمنتمي إليهم، وهذا المصطلح التنظيمي (رفيق) ارتبط قديما بالحركات الإسماعيلية، وفي عصرنا بالحركات اليسارية والتنظيمات النقابية في الشرق والغرب.
وكذلك استخدموا مصطلح ‘النقيب‘ وهو وصف يطلق في حركة مثل جماعة الإخوان المسلمين على المسؤول التنظيمي الذي يترأس مجموعة من الأفراد (أسرة/ خلية تنظيمية). وفي جماعات الفتوة؛ كان النقيب الذي يأخذ البيعة يرفع الأمر إلى القائد مرددا: “أيها السيد! إن هؤلاء يسألونك أن تقبل فلانا رفيقا في الفتوة؛ فيقول: السمع والطاعة لله ولرسوله ثم للجماعة..، ويقول النقيب: هذا عهد الله بينكما على التمسك بشروط الفتوة”.
وقد ذكر الإمام تقي الدين السبكي تفاصيل مشهد بيعة الفتيان التنظيمية في فتاويه ضمن سؤال ورده بشأنها، ومنها: “ثم يأتي النقيب بالشربة المذكورة (= ماء مملّح) فيقدمها إلى شيخهم فيأخذها بيده ثم يقول: السلام يا فتيان! السلام مرتين، اللهم اجعل وقوفي لله واتباعي بالفتوة لآل بيت رسول الله ﷺ أخص بهذه الشربة العفيفة النظيفة لكبيري فلان ويسميه، ثم يسندها عن شيخ بعد شيخ إلى الإمام الناصر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم يشرب ويدفعها إلى غيره فيفعل كذلك، حتى يشرب القوم جميعهم”. وبشأن استنكار الفقهاء لتنظيمات الفتوة وطقوسها ومعتقداتها يقول ابن الوردي في تاريخه: “وكان بعض الفضلاء قد استفتى في هذه الفتوة بمصر والشام، وأخذ بتحريمها خطوط العلماء الأعلام”.
ويرى مؤرخ الأفكار المصري أحمد أمين (ت 1334هـ/1954م) -حسبما ذهب إليه في كتابه ‘الصعلكة والفتوة في الإسلام‘- أن جماعة الإخوان المسلمين من حيث نمط التنظيم ربما تكون هي أقرب التنظيمات المعاصرة إلى حركة الفتيان التاريخية؛ وفي ذلك يقول: “ربما كان قريبا من نظام الفتوة -في أيامنا هذه- جمعية الإخوان المسلمين…، والحق أن الناظر إليهم كان يراهم أميز من زملائهم من حيث الفتوة والرجولة والتخلق بالأخلاق الحسنة، ثم دعتهم الظروف المحيطة بهم أن يتحزبوا… كما تحزب التابعون للأحزاب الأخرى”.
ولعل هذا أدق تحليل يمكن الاستناد إليه لفهم من أي مصدر ربما يكون الشيخ حسن البنّا (ت 1369هـ/1949م) أخذ منه فكرة ونمط تأسيس “الإخوان”، لاسيما أن الحركة كان لها اهتمام بالجانب المسلح في فترةٍ ما قبل ثورة “الضباط الأحرار” بمصر سنة 1372هـ/1952م.
تأثر أوروبي
يذهب كثير من الباحثين إلى أن نظام الفروسية -الذي ارتبط تاريخيا بالإقطاع في أوروبا- كان متأثرا بالنموذج العربي للفتوة؛ فمواجهات الجيوش والفرسان من الطرفين -خصوصا في الحروب الصليبية- وما أظهروه فيها من نُبْل وفروسية ومدنية، كانت لها انعكاساتها في أوروبا القرون الوسطى. ويرى المستشرق الفرنسي جوزيف رِينُو (ت 1283هـ/1867م) –فيما يرويه عنه محمد عبد الله عنان في كتابه ‘دولة الإسلام في الأندلس‘- أن “السبب الحقيقي لهذه الظاهرة المدهشة (= إعجاب الأوروبيين آنذاك بالعرب) هو الأثر الذي بثته قصص الفروسية في العصور الوسطى، وهو أثر لا يزال ملموسا إلى يومنا”.
ويؤكد مؤرخ الحضارات الأميركي وِلْ ديورانت (ت 1402هـ/1981م) -في ‘قصة الحضارة‘- أن “من العادات الألمانية القديمة عادات التعليم العسكري، بعد أن تأثرت بأساليب المسلمين في بلاد الفرس والشام والأندلس، وبالأفكار المسيحية المتصلة بالخشوع والأسرار المقدسة؛ من هذه كلها نشأ نظام الفروسية، وهو نظام لم يبلغ حدَّ الكمال ولكنه نظام نبيل كريم”.
ويقول واصف بطرس غالي باشا (ت 1328هـ/1910م) –طبقا لما ينقله عنه عمر الدسوقي في كتابه ‘الفتوة عند العرب‘- إن الفتوة الناصرية شاعت في مشارق الأرض ومغاربها حتى بلغت أوروبا، ورأيه أنه “لا ترجع الفروسية الفرنسية إلى أصل روماني أو ألماني ومسيحي أو عربي، وليس معنى ذلك أنها لم تتأثر بالمدنية العربية، إنها تأثرت بالتقاليد العربية فعلا في إسبانيا وفي فلسطين وفي مصر إبان الحروب الصليبية”. لكن الدسوقي يؤكد أن كثيرا من الباحثين الغربيين يرون أن “أوروبا لم تعرف الفروسية إلا عن العرب”.
وينبغي ألا نستغرب ذلك؛ فقد تحدث الرحالة ابن بَطُّوطَة (ت 779هـ/1377م) عن انتشار جماعات الفتوة –ذات الارتباط بالفروسية- في بلاد الأناضول وهي آنذاك لا تزال متاخمة للدولة البيزنطية، فقال إن “مدينة قونية… مدينة عظيمة حسنة العمارة… وشوارعها متّسعة جدّا، وأسواقها بديعة الترتيب…، نزلنا منها بزاوية قاضيها ويعرف بابن قلم شاه، وهو من الفتيان وزاويته من أعظم الزوايا، وله طائفة كبيرة من التلاميذ، ولهم في الفتوّة سند يتّصل إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب..، ولباسها عندهم السّراويل كما تلبس الصوفيّة الخرقة”؛ فهل كانت الدولة البيزنطية بوابة لعبور نظام الفتوة وما يرتبط به من فروسية إلى أوروبا؟