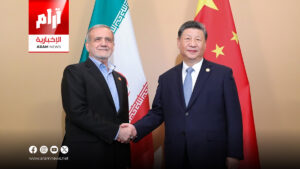ألف امرأة استشهدت دفاعاً عنه.. المسجد الأقصى “ثالث الحرمين الشريفين”

يقول الإمام القاضي ابن العربي المالكي الأندلسي (ت 543هـ/1148م) في كتابه ‘سراج المريدين‘: “لقد كان في بيت المقدس نسوة يُفْخَرُ بهنّ على الأزمنة؛ يَلْتَفِفْنَ على العالمة الشيرازية: فقيهة واعظة متعبدة متبتّلة؛ فلما دخل الروم بيت المقدس يوم الجمعة لاثنتيْ عشرة ليلة بقيت لشعبان من سنة ثنتين وتسعين وأربعمئة (492هـ/1099م) لجأت بهن أجمعين إلى المسجد الأقصى، وجلسن في قبة السلسلة..، فلما غشيتهن الروم قمن إليهم بالسب ورمي التراب في وجوههن، فحصدوهن بالسيوف وأنزلوا بهن الحتوف. قال لي من عاين ذلك وهو في سطح المسجد الأقصى: كن قريبا من ألف امرأة”!!
ألف امرأة..؟!! نعم، ألف امرأة كُنَّ يُرابطْنَ في رحاب المسجد الأقصى عابداتٍ قانتاتٍ عالماتٍ ومتعلماتٍ، تصدَّيْنَ لأبشع هجمة بربرية استهدفت المسجد الأقصى في تاريخه!! إننا لا نتحدث عن نضالات المرابطين والمرابطات اليوم دفاعا عن الأقصى أمام همجية الاحتلال الصهيوني والتي تنقلها القنوات الفضائية لحظة بلحظة، بل نتكلم عن الهجوم الصليبي الدموي على المسجد الأقصى قبل قرابة ألف سنة من الآن!!
وكما يخبرنا الإمام ابن العربي -في نصه الآنف- فإنه كان في الأقصى حينها “تنظيم رباطي” يتألف من زهاء ألف امرأة يتبعن لقيادة علمية نسوية واحدة، وقد تحولن في لحظة العدوان الرهيبة تلك إلى مدافعات شرسات عن الأقصى حين اقتحم ساحاتِه الصليبيون، وثبَـتْنَ في دفاعهن عنه حتى استشهدن جميعا وهن صابرات صامدات!!
هذا المشهد الافتتاحي المَجيد -والقديم المتجدد في نضال حركة “نساء الأقصى” اليوم- هو خير ما نستهل به القول حين نحاول رسم صورة قلمية معبّرة عن مكانة المسجد الأقصى في قلوب العرب والمسلمين. وإن أول ما يلفت النظر في تاريخ المسجد الأقصى هو كيفية اتخاذ قرار تنفيذ أول مشروع لتطوير بنائه في التاريخ الإسلامي! فقد كانت إقامة قبة الصخرة في المسجد الأقصى بمشورة طلبها الخليفة حينها من المسلمين، فجاء تشييدها بمشاركة من الأمة وربما بـ”إجماع” منها آنذاك.
الأمر الآخر اللافت في تاريخ الأقصى هو ارتباط اسمه بمفهوم “الرباط”! والرباط أصلا هو تلك المحاضن النُّسُكِيّة الجهادية التي ينشئها العُبّاد على ثغور الحدود المفتوحة مع الأعداء، فيجسّدون بذلك الوصفَ الوارد في الأثر: “رُهبانٌ بالليل، لُيُوثٌ بالنهار”!! وقد استُشهد من هؤلاء المرابطين -في مذبحة الاستعمار الصليبي القديم- ثلاثة آلاف من العلماء والصُّلَحاء كانوا زينة أروقة المسجد الأقصى وأكنافه المباركة!!
وقد كان في طليعة مشاهير المرابطين فيه الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505هـ/1111م)، وهو وإن لم يشهد قطعا مذبحة الأقصى الصليبية فإنه ألّف -حسب إحدى الروايات- في رحابه كتابَه العظيم “إحياء علوم الدين” الذي صاحب المجاهدين أينما حلّوا، وتربى به الألوف من المحاربين في الدول الزنكية والأيوبية والمملوكية؛ تلك الدول التي قدّمت أعظم مشروعات التحرر والمقاومة في تاريخ الأمة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه العدوان -في أيامنا هذه- على القدس والأقصى وأكنافهما في قالب صهيوني صنعته قوى غربية ومكنت له؛ فإن نداء المرابطة للدفاع عن ثغور المقدسات لا يزال صدّاحا في سماء الأقصى، مؤكدا -كما تدلّ عليه أحداث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لباحاته وجنباته- أن قصته لا تزال هي القضية المركزية بـ”إجماع” من الأمة!! وهو ما تسعى هذه المقالة لكشف أدلته وتجلياته العملية في شتى حِقَب تاريخ المسلمين.
فضل راسخ
يعدّ المسجد الأقصى ثاني مسجد وُضع للناس في الأرض بعد المسجد الحرام بمكة؛ فقد روى البخاري (ت 256هـ/870م) عن أبي ذر الغفاري (ت 32هـ/654م) -رضي الله عنه- أنه قال: “قلت يا رسول الله، أيّ مسجد وُضع في الأرض أولَ؟ قال: «المسجد الحرام»، قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى»”. كما أن المسجد الأقصى آية في كتاب الله عز وجل: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ}.
وإذا كانت الأحاديث والآثار الشرعية قد تواترت على فضل المسجد الأقصى؛ فإن الذي يهمنا في هذا المقال هو محاولة رصد الشواهد العملية لذلك الفضل في تاريخ المسلمين عبر العصور، وكيف تجلت مظاهره في حياتهم حين جعلوا منه محضنا للعبادة والعلم والتربية وثغرا للمرابطة والجهاد.
ولعلّ أول ما يُذكر في بيان منزلة المسجد الأقصى العملية في قلوب المسلمين هو عراقة ما ألّفه العلماء المسلمون في فضل المسجد الأقصى؛ إذ التأليف في فضائل بيت المقدس قرينٌ لتاريخ التدوين الإسلاميّ برمّته، فأول كتابٍ في ذلك صنّفه بشر بن إسحق البلخي (ت 206هـ/831م) بعنوان: “فتوح بيت المقدس”، وهو أقدمُ من كتابيْ الأزرقي (ت 250هـ/864م) والفاكهي (ت 272هـ/885م) المدوَّنيْن في أخبار مكة المشرّفة.
أما أول كتابٍ صُنِّف باسم “فضائل بيت المقدس” فهو للوليد بن حمّاد الرمليّ (ت نحو 300هـ/912م)، وهو معاصرٌ لأصحاب الكتب الستة وقد ترجم له الإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م) في ‘سير أعلام النبلاء‘ فوصفه بأنه “الحافظ… وكان ربّانياً”. ثم توالت الكتب في فضائل بيت المقدس وتاريخه فبلغت عددًا يصعبُ حصره.
سابقة فريدة
كان ذلك من العناية المعنوية والتاريخية والفكرية ببيت المقدس؛ أما من الناحية العملية فأول ما يُذكر في منزلة بيت المقدس في ضمير الرأي العام الإسلامي هو ما بُذل في عملية بنائه وعمارته وزينته. ففي اللحظة الأولى التي استلم فيها الخليفة عمر الفاروق (ت 23هـ/645م) القُدسَ فاتحا سنة 16هـ/638م؛ سار إلى مكان الصخرة “فوجد على الصخرة زبلًا كثيرًا مما طرحته الروم غيظًا لبني إسرائيل، فبسط عمر رداءه وجعل يكنس ذلك الزبل، وجعل المسلمون يكنسون معه”؛ وفقا للمؤرخ مجير الدين العُلَيْمي (ت 928هـ/1522م) في ‘الأنْس الجليل بتاريخ القدس والخليل‘.
ومِمّا يُسجّل هنا للمسجد الأقصى أن أول مشروع تطويري لبنائه بُني بقرار من الأمّة ولم تنفرد بشرف تعميره السلطة وحدها؛ فقد ذكر الإمام سبط ابن الجوزي (ت 654هـ/1256م) -في ‘مرآة الزمان‘- أنه “لمَّا عزم عبد الملك (بن مروان ت 86هـ/706م) على بنائها (= قبة الصخرة)؛ كتبَ إلى أهل الأمصار ممَّن هو في طاعته..: أمَّا بعد، فإنَّ أمير المؤمنين قد عزمَ على بناء قُبَّة على صخرة بيت المقدس، تكونُ للمسلمين ظِلًّا وكنفًا..، وإنه كره أن يشرع في ذلك قبل أن يستشير أهلَ الرأي.. والفضل من رعيَّته؛ قال الله تعالى: {وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] فليكتبوا إليه ما عندهم فيما عزم عليه! فكتبوا إليه: ليُتَمّمْ أميرُ المؤمنين ما عزمَ عليه من بناء بيت الله المقدَّس، وتزيين المسجد الأقصى، أجرى الله الخيراتِ على يديه”.
ولئن كان مؤرخون رأوا أن قصد عبد الملك من استشارة الأمة ناشئ عن ضعف جبهته الداخلية بسبب النزاع على الخلافة مع الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير (ت 73هـ/693م)؛ فإنّ ذلك لا يطعن في حقيقة أن المسجد الأقصى عُمِّر بإرادة جماعية استثنائية من الأمّة في زمن الملك الجبريّ!
لقد كلّف عبد الملك رجلين من خيرة رجاله: الفقيه المحدث رجاء بن حيوة (ت 112هـ/731م) ويزيد بن سلام (مولى الخليفة ت بعد 72هـ/692م) بالإشراف على البناء، لكنه مع ذلك عُني بأدقّ تفاصيل البناء قبل الشروع فيه. فسبط ابن الجوزي يخبرنا أن عبد الملك “جمع الصُّنَّاع والمهندسين من الآفاق، وأمرهم أن يُصَوِّروا القُبَّةَ قبل بنائها، فصوَّرُوها له في صحن المسجد، فأعجبَه”! وهذا يُشبه فكرة ما يُعرف اليوم -في مجال تصاميم البناء الهندسية- بـ”النموذج المعماري” (الماكيت – Maquette) الذي يوضع للبناء قبل تنفيذه!!
عناية متزايدة
نجد عند الإمام المؤرخ ابن كثير (ت 774هـ/1372م) -في ‘البداية والنهاية‘- توثيقا لتاريخ انتهاء بناء قبة الصخرة؛ إذْ يقول إنه “لمّا كمل البناءُ كتبوا على القبة -مما يلي الباب القبلي من جهة الأقصى- بالنص بعد البسملة: ”بَنَى هذه القبةَ عبدُ الله عبدُ الملك أميرُ المؤمنين سنة اثنتين وسبعين من الهجرة النبوية (72هـ/692م)“”.
ومنذ ذلك الحين؛ والعناية بالمسجد الأقصى تكْبرُ وتزداد، حتى جزم العُليمي بتفوّق المسجد الأقصى على جميع مساجد عصره من حيثُ المساحة والعمران؛ فقد عقد فصلا بعنوان: “ذكر صفة المسجد الأقصى وما هو عليه في عصرنا”، فقال: “اعلم.. أن المسجد الأقصى الشريف.. ليس له نظير تحت أديم السماء، ولا بُني في المساجد صفته ولا سعته”!! وهو ما أكده قبل ذلك بقرن ونصف الرحالة ابن بطوطة (ت 779هـ/1377م)، فقد زار القدس ووصف الأقصى بأنه “ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه”!!
ولا عجب في جزمهما هذا؛ فمساحة المسجد الأقصى داخل السور القديم تبلغ 144 ألف متر مربع، وحتى خمسينيات القرن العشرين الماضي كانت مساحته أضعاف مساحة الحرمين الشريفين. فبحسب المعطيات الرسمي السعودية؛ فإن مساحة المسجد الحرام بمكة قبل سنة 1376هـ/1956م تقدر بنحو 28 ألف متر مربع، وأما المسجد النبويّ فإنّ مساحته قبل سنة 1372هـ/1952م كانت تزيد على 10 آلاف متر مربع بقليل؛ ثم لم يزل حال المسجدين في اتساع، وبقي الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني على حاله حتى تجاوزاه.
أما على مستوى تعهده بأنواع الزينة والاحتفاء؛ فإن المسجدُ الأقصى زُيِّن -منذ بنائه- بأعدادٍ مهولةٍ من القناديل المعلقة سلاسل الذهب والفضة متعددة الأحجام والأوزان، وظل الأمر كذلك حتى وقت متأخر نسبيا وهو القرن التاسع الهجري/الـ15 الميلادي.
إذْ يذكر شمس الدين الأسيوطي (ت 880هـ/1475م) -في ‘إتحاف الأخِصّا بفضائل المسجد الأقصى‘- أن فيه “من السلاسل للقناديل أربعمئة سلسلة إلا خمس عشرة، منها مئتا سلسلة وثلاثون سلسلة في المسجد، والباقي في قبة الصخرة، وذرْعُ السلاسل أربعة آلاف ذراع (الذراع = 53سم تقريبا)، ووزْنها ثلاثة وأربعون ألف رطل بالشامي (= نحو 1900 غرام)، ومن القناديل خمسة آلاف قنديل”!!
وهذه القناديل من الذهب والفضّة لم تكن مجرّد إضاءة ولا زينة، بل كانت تُعدّ ثروةً في نفسها، لم يغفل الغُزاة عن قيمتها فانتهبوها في كل احتلال يبتلى به الأقصى والقدس الشريف. فأبو الفرج ابن الجوزيّ (ت 597هـ/1201م) يذكر مثلا -في ‘المنتظم‘- أن الصليبيين حين احتلوا القدس والأقصى سنة 492هـ/1099م “أخذوا من عند الصخرة نيفا وأربعين قنديلا فضة، كل قنديل وزنه ثلاثة آلاف وستمئة درهم (= قيمتها اليوم 4500 دولار تقريبا)، وأخذوا تنور فضة وزنه أربعون رطلا بالشامي، وأخذوا نيفا وعشرين قنديلا من ذهب”!!
إدارة خاصة
أما قبة الصخرة؛ فقد بُذل لها -منذ انتهاء بنائها- من الرعاية الفائقة والخدمات الجليلة ما يليق بها، ومن ذلك تطييبها وتبخيرُها في مراسم غاية في الجمال والعجب، على أيدي فريقٍ من الموظفين خُصّص لخدمتها والعناية بها؛ فالإمام المؤرخ ابن كثير يحدثنا -في ‘البداية والنهاية‘- أن عبد الملك بن مروان لما بنى قبة الصخرة خَصَّص “لها سَدَنَةً وخُدَّاماً”.
ويخبرنا سبط ابن الجوزي -في مرآة الزمان- بأن فريق الإدارة هذا كان له زيٌّ رسميّ خاص به، ولعمله ترتيبٌ بالغ الدقّة والنظام؛ فيقول: “كان السَّدَنةُ -[في] كلِّ اثنين وخميس- يُذِيبون المِسْك والعنبر والماوَرْد والزَّعْفران، فيعملون منه غاليةً (= طِيب) بماء الورد الجُوريّ (= أجود أنواع ماء الورد)، ويُخَمَّر من الليل، ثم يدخلُ الخدمُ صُبْحةَ كلِّ يوم من هذين اليومين الحمَّام، فيغتسلون ويتطهَّرون، ثم يدخلون الخزانةَ التي فيها الخَلُوق (= الطيب) فيخلعون ثيابهم، ويلبسون ثياب الوَشْي، ويشدُّون أوساطَهم بالمناطق المحلَّاة بالذهب”.
ويضيف -متحدثا عن كيفية تطييبهم لقبة الصخرة- أنهم كانوا “يُخَلِّقُون (= يطيِّبون) الصخرة، ثم يوضع البَخُور في مجامر الذهب والفضة، وفيها [العُود] القَمَاريُّ المَطْليُّ بالمسك، وتُرخي السَّدَنَةُ السُّتُور، فيستديرُ البَخُور على الصخرة كلِّها، فتعبَقُ الرائحة، ثم تُرفع السُّتور، فتخرج تلك الرائحةُ حتَّى تملأ المدينةَ كلَّها، ثم يُنادي منادٍ: ألا إنَّ الصخرةَ قد فُتحت، فمن أرادَ الزيارة فليأتِ! فيُقبلُ الناسُ مبادِرين إليها، فيُصلُّون ويخرجون، فمن وُجدت منه رائحةُ البَخُور؛ قيل: هذا كان اليومَ في الصخرة”!!
وظلت الصخرة ومسجدها محطّ اهتمام السلاطين فيما بعد، وازدادت العناية بها بعد تحريرها من الصليبيين؛ فقد أورد عماد الدين الأصفهاني (ت 597هـ/1201م) -في ‘الفتح القِسِّي‘- أنه “رتّب السلطان صلاح الدين الأيوبي (ت 589هـ/1193م)] في قبة الصخرة إماما من أحسن القراء تلاوة، وأزينهم طلاوة، وأنداهم صوتا، وأسماهم في الديانة صيتا، وأعرفهم بالقراءات السبع بل العشر..، وقف عليه داراً وأرضا وبستانا، وأسدى إليه معروفا دارًّا وإحسانا”.
ثم تحدث الأصفهاني عما رصده صلاح الدين من مقتنيات وإدارة لعمارة القبة والمسجد؛ فقال إنه “حُمل إليها وإلى محراب المسجد الأقصى مصاحف وختمات؛ ورَبْعات (= مصاحف موزّعة 30 جزءا) معظَّمات..، ورتّب لهذه القبة خاصة وللبيت المقدّس عامة قَوَمَةً (= موظفين) لشمل مصالحها ضامّة، فما ترتب إلا العارفون العاكفون، والقائمون بالعبادة الواقفون؛ فما أبهج ليلها وقد حضرت الجموع! وزهرت (= أضاءت) الشموع! وبان الخشوع! ودان الخضوع! ودرت من المتقين الدموع! واستعرت من العارفين الضلوع!”. ولشدة الزحام والإقبال على قبة الصخرة والمسجد كان “أكثر الناس من يدرك أن يصلي ركعتين، وأقلهم أربعًا”؛ وفقا للعُليمي في ‘الأنْس الجليل‘.
معالم خالدة
أما أهمّ معالم الأقصى العمرانية؛ فإنه إذا ذكُر المسجد الأقصى اليوم فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو صورة “مسجد قبة الصخرة” المشرّفة الأزرق ذي القبة الذهبية، إلا عند العامة من أهل القدس فإنهم تنصرفُ أذهانهم إلى “المسجد القِبليّ” ذي القبة الرصاصية. والحقيقة خلاف هذا وذاك؛ إذْ يقول العُلَيمي إن “المتعارَف عند الناس أن الأقصى -من جهة القبلة- الجامعُ المبني في صدر المسجد الذي به المنبر والمحراب الكبير، وحقيقة الحال أن الأقصى اسم لجميع المسجد مما دار عليه السور”!
وهذا الذي قاله العُليمي هو المعتمد اليوم عند المتخصصين، وصار معروفًا لكثيرٍ من العامّة بسبب التوعية المتكررة به. وفيما يلي محاولةٌ لوصف أهمّ معالم المسجد الأقصى بين الأمس واليوم، بالاعتماد على الوصف البديع التفصيلي الذي أودعه العُلَيمي كتابه ‘الأنْس الجليل‘:
1- المسجد القبلي: قال العُليمي في وصفه: “الجامع الذي هو في صدره (= صدر المسجد الأقصى) عند القبلة، الذي تقام فيه الجمعة، وهو المتعارف عند الناس أنه ”المسجد الأقصى”، يشتمل على بناء عظيم به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص الملونة، وتحت القبة المنبر والمحراب”، وعلى القبة “رصاص من ظاهرها” كما هو شكلها حتى الآن، وما زال هذا البناء هو المسجد المركزيّ، وفيه منبر صلاح الدين/نور الدين زنكي (ت 569هـ/1173م) الذي عليه يقف الخطيب كل جمعة.
2- مسجد قبة الصخرة: وهو المسجدُ مثمّن الأضلاع ذو القبة الذهبية الشهيرة، وقد سبق ذكْرُ أنّ عبد الملك أمر بصبّ مئات آلاف الدنانير عليها، فكانت ذهبيّة فعلا لا مطلية بالذهب فحسب. ولئن كانت الجمعة لا تُقام في مسجد قبة الصخرة فإنه فيه كان “يُصلَّى.. العيدُ والاستسقاء” في العصر القديم؛ وفقا للعُليمي.
ويُفهم من كلام العُليمي وغيره أنه كان لمسجد قبة الصخرة إمام مستقلّ؛ فقد ترجم لغير واحدٍ بكونه “إمام مسجد الصخرة”. أما الآن؛ فلا تُقام بمسجد الصخرة صلاة مستقلة، بل الصلاة فيه تبعٌ للصلاة في المسجد القبليّ، وعادةً تُصلي فيه النساء خصوصًا في الجُمَع والمواسم.
3- قبة السلسلة: في المسجد الأقصى قبابٌ كثيرة سوى القُبّتين الشهيرتين، وكلها أصغر حجما منهما. وأشهرها “قبة السلسلة” التي وصفها العُليمي بأنها “قبة في غاية الظرف على عُمُد من رُخام”، وقد بُنيت لتكون مجسَّما مصغَّرا لقبة الصخرة قبل بنائها، ولذا فهي “على صفة قبة الصخرة”؛ وفق تعبير العُليمي.
4- الأقصى القديم والمصلى المرواني: كلاهما يقع شرقيّ “المسجد القبلي”، أما “الأقصى القديم” فيقع تحت المسجد القبليّ من جهة المحراب، وإلى جواره يقع “المصلى المروانيّ”. قال العُليمي: “وسُفْلَ (= أسفل) المسجدِ -من جهة القبلة- مكان كبير معقود (= مبنيّ)، وبه أسوار حاملة للسقف..، ويسمى هذا المكان السفلي “الأقصى القديم”..، وإلى جانب هذا المكان -أيضا سُفْلَ المسجد تحت الجهة التي بها الأشجار والزيتون- مكان عظيم معقود”. وهذا المكان هو الذي يُعرف اليوم بـ”المصلى المروانيّ”.
5- حائط البراق: وهو السور الغربيّ للمسجد الأقصى المبارك، يقعُ فيه “باب المغاربة” الذي يُعتقد أن النبيّ ﷺ دخل منه المسجد الأقصى ليلة الإسراء “فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد”؛ طبقا لرواية الإمام ابن القيم (ت 752هـ/1351م) في ‘زاد المعاد‘. والسور الغربيّ للمسجد [حائط البراق] هو الذي يسميه الصهاينة اليوم “حائط المبكى”.
6- الأبواب: للمسجد الأقصى -سوى باب المغاربة- خمسة عشر بابا، بعضُها مفتوح والآخر مسدود. وأشهر الأبواب المفتوحة: “باب السلسلة” و”باب السكينة”، اللذان يقول عنهما العُليمي: “ومنهما يخرج إلى الشارع الأعظم..، وهما عُمدة أبواب المسجد، وغالب استطراق (= دخول) الناس إلى المسجد منهما”! ولا يزال هذا البابان على أهميتهما هذه، بل ازداد اعتماد الناس عليهما بعد إغلاق الاحتلال “باب المغاربة” منذ 1387هـ/1967م.
7- القناطر: أما القناطر فهي أحدُ أهمّ معالم الجمال في صحن قبة الصخرة المشرّفة، وقد وصفها العُليمي بقوله: “الصحن مفروش بالبلاط الأبيض، ويُتوصّل إليه من عدة أماكن من صحن المسجد، كلّ مكان به سُلّم من حجر، وعلى رأس السلم قناطر (= أقواس) مرتفعة على عُمُد”. وتُسمّى هذه القناطر في بعض الكتب “البوائك” جمع بائكة، وهي تحفة معمارية بديعة.
8- المَساطب: واحدتها مَسْطبة، وهي أماكنُ مرتفعة عن الأرض بأقل من متر، ويُرتقى إليها بدرج وتُعقد فيها مجالسُ العلم عادة. وربما نظّمت فيها قديما الاجتماعاتُ العامة؛ فقد ذكر العُليمي نماذج لذلك كان أحدها حضوره اجتماعًا مهمًّا لكبار المسؤولين والعلماء عُقد “بالمسجد الأقصى على المسطبة الكائنة عند باب جامع المغاربة”، وذلك في ربيع الأول 879هـ/1474م لمناقشة مشكلة ثارت حينها بشأن “كنيسة اليهود بالقدس”.
حاضنة تربوية
إلى جانب العمارة الإنشائية والخدمية للمسجد الأقصى بمرافقه وملحقاته المتعددة؛ نجد نمطا آخر من العناية ذا صلة أكبر بالمكانة المقدسة لهذا المسجد الشريف، وهو ما يمكن تسميته بـ”العمارة النُّسُكية” التعبدية التي تتجاوز الحرص على الشهود اليومي للصلوات الخمس فيه إلى ربطه ببعض أركان الإسلام الأخرى كالحج والصيام.
إذْ كان كثيرٌ من الصالحين يُحبّ أن يُحْرِم للحجّ من المسجد الأقصى؛ وأصلُ هذه العادة جاء عملا بحديث رواه الإمام أبو داود (ت 275هـ/888م) من طريق أمِّ المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ (ت 61هـ/682م) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».
ورغم أن إسناد الحديث لا يخلو من مقال؛ فإن أبا داود عضده بالعمل فقال: “يَرْحَمُ اللَّهُ وَكِيعًا (بن الجَرّاح الإمام الحافظ ت 197هـ/813م) أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ يَعْنِي إِلَى مَكَّة”. كما قال الإمام البَغَوي (ت 516هـ/1122م) -في ‘شرح السنّة‘- إن الإحرام للحج من الأقصى “قد فعله غير واحد من الصحابة”. فيبدو أن هذه العادة متأصلة منذ زمن الصحابة الكرام، وقد بقيت شائعة في أجيال المسلمين حتى احتلال المسجد الأقصى من الصهاينة.
ولعلّ أجمل قصة إحرام من المسجد الأقصى ذكرها المؤرخون، وأبلغها بيانا لمكانة الأقصى في قلوب المسلمين؛ هي حكاية إحرام طائفةٍ من المجاهدين جاؤوا إلى القدس من مختلف مناطق الشام والجزيرة الفراتية وديار بكر الواقعة اليوم في جنوب شرقي تركيا، وشاركوا في تحريرها من الصليبيين سنة 583هـ/1187م.
فقد ذكر الفتح بن علي الأصفهانيّ (ت 643هـ/1245م) -في ‘مختصر سنا البرق الشاميّ‘- أنه “لمّا وقع الفراغ من فتح القدس دنا الحج..، وقالوا (= المجاهدون): نُحْرِمُ من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام، ونفوز مع إدراك فضيلة [استعادة] القدس -في هذا العام- بأداء فريضة الجهاد والحج ركنيْ الإسلام”.
“تقديس” عريق
أما زيارة بيت المقدس في ختام رحلة الحج -التي تسمى “تقديس الحجّ”- فظلت عادةً أكثر انتشارًا من سابقتها؛ فكان كثيرٌ من المسلمين يحجّون ثم يقصدون المسجد النبوي بالمدينة المنورة للزيارة والصلاة فيه، ثم لا يرون أتمّ ولا أجمل لحجّهم من أن “يُقدّسوه” بزيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى.
وقد غلط باحثون نسبوا هذه العادة إلى عهود الدولة العثمانية؛ إذْ هي عادةٌ متأصلة في تاريخ المسلمين لكونها مبنيّة في الأصل على الحديث المشهور: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد» (رواه البخاري ومسلم)؛ فكأنه لما جمع الحديثُ ذكْرَ المساجد الثلاثة في سياق واحد أحبَّ المسلمون الجمع بين زيارتها جميعا في رحلة الحج.
بل إن “الحملة الرسمية للحج” كانت تفعل هذا “التقديس” منذ القرون الأولى؛ فقد قال ابن الجوزي -في ‘المنتظم‘- ضمن أحداث سنة 140هـ/758م: “خرج [الخليفة العباسي] أَبُو جعفر المنصور حاجًّا فأحرم من الحِيرة [جنوبي العراق]، ثم رجع بعد ما قضى الحج إلى المدينة [النبوية]، فتوجه منها إلى بيت المقدس (مطلع سنة 141هـ/759م) فصلى في مسجدها، ثُمَّ سلك إلى الشام منصرفا” نحو العراق. ثم صار “التقديس” في القرون المتأخرة جزءًا من رحلة الحجّ لا غنى عنه للحُجّاج.
والعجيب أنه وُجد أيضا من العلماء والعبّاد من يتقصد صيام شهر رمضان في الأقصى على غرار توخي الإحرام بالحج منه؛ فالإمام القاضي ابن العربي الأندلسي المالكي (ت 543هـ/1148م) يسجّل حضور هذا المعنى عند جماعات المتبتِّلين في رحاب الأقصى، فيقول في ‘سراج المريدين‘: “وكان يرد علينا في بيت المقدس كلَّ عام من جبال الشام جماعة من المتبتِّلين (= المتعبِّدين)، يصومون بالمسجد الأقصى شهر رمضان، ثم يرجعون إلى جبالهم وكهوفهم”!!
لقد كانت سعة المسجد الأقصى تسمح بإقامة أكثر من صلاة فيه عندما استُحْدِث فيه تعددُ المحاريب تبعا لتعدد المذاهب الفقهية الأربعة ، كما حصل في الحرمين بمكة والمدينة بدءاً من القرن الخامس الهجري/الـ11 الميلادي؛ غير أن العلماء كأنهم كرهوا أن تقام صلاتان للجماعة في الوقت نفسه، فجعلوا للصلوات ترتيبا زمانيًّا ثابتا وفقا للمذاهب.
وقد ذكر العليمي -في ‘الأنس الجليل‘- تفصيل الأئمة وترتيب الصلوات؛ فقال: أما الأئمة المرتبون فيه فأولهم إمام المالكية، يصلي في الجامع الذي غربيّ المسجد من جهة القبلة [جامع المغاربة]..، ثم يصلي بعده إمام الشافعية بالجامع الكبير القِبْلي المتعارَف عند الناس بالمسجد الأقصى، ثم يصلي بعده إمام الحنفية بقبة الصخرة الشريفة، ثم يصلي بعده إمام الحنابلة”. أما الجمعة فكانت تُقام في المسجد القِبْلي فقط.
ويضيف العليمي: “وللمسجد الأقصى أيضا عدة أئمة بداخل الجامع الأقصى وبمغارة الصخرة وعند أبواب المسجد يصلون التراويح في رمضان فقط، وبقية الأيام لا يصلون شيئا ولكن العمدة على الأئمة الأربعة المتقدم”.
منارة علمية
وغير بعيد عن العمارة النُّسُكية للمسجد الأقصى؛ كان من أبرز مظاهر عناية المسلمين بالأقصى أنهم جعلوا منه مركزًا علميًّا قَلَّ نظيرُه في تاريخ المسلمين؛ وذلك برعاية أهلية من فئة التجار والمحسنين، وعناية رسميّة من الدول المتعاقبة على المسؤولية عن القدس، إذْ يقرر العليمي أن جميع “الملوك والأعيان.. وقفوا أوقافا على مصالح المسجد الأقصى وخدمته”.
ومما يدلّ على أن الرعاية الرسمية للنشاط العلمي ببيت المقدس بدأت مبكرة جدًّا وكانت سخيّة؛ ما نقله الذهبيّ -في ‘سير أعلام النبلاء‘- عن “الإمام القدوة شيخ فلسطين” إبراهيم ابن أبي عَبْلة (ت 152هـ/770م) من أنه كان يقول عن الخليفة الأمويّ الوليد بن عبد الملك (ت 96هـ/716م): “رحم الله الوليد! وأين مثل الوليد؟ افتتح الهند والأندلس، وبنى مسجد دمشق (= الجامع الأموي)، وكان يعطيني قطع الفضة أقسمها على قُرَّاء (= علماء) مسجد بيت المقدس”!!
وبالطبع تعززت تلك الرعاية الرسمية لمكانة الأقصى العلمية بجهود بالغة بذلها العلماء من كل المذاهب والتخصصات، وعُضّدت بالتفافٍ وإقبال واسع من طلبة العلم من جميع أقطار العالم الإسلاميّ؛ فقد بدأ اتخاذ المسجد الأقصى مدرسةً -منذ القرن الأول الهجريّ/السابع الميلادي- لإقراء القرآن أولًا، ثم لرواية الحديث النبوي وتدريس سائر العلوم الإسلامية.
وإذا كان النشاط العلميّ شهد ازدهارَه الكبير ببيت المقدس بعد تحريره من الصليبيين أواخر القرن السادس الهجريّ/الـ12 الميلادي، بإحياء “المدرسة النصريّة” (الصلاحيّة بعد الاحتلال الصليبي)؛ فإن كتب التاريخ لم تخلُ مما يدلّ على أن الأقصى كان جامعةً علميّة كبيرة -تنافس أهمّ المدارس الإسلامية- قبل الاحتلال الصليبيّ والتحرر منه، فازدهرت فيها النقاشات العلمية، وصُنِّفت المؤلفات الرائدة، ومنها انتشرت مذاهب معتبرة، واحتضنت باكورة المدارس المؤسسة في الشام.
فهذا الإمام ابن العربي المالكي -الذي يحدثنا كثيرا في العديد من مؤلفاته عن مشاهداته في الأقصى قُبَيل الاحتلال الصليبي للقدس- يبدي اندهاشه من العمارة العلمية للأقصى وتنوع النشاط المدرسي فيه، حتى إنه لما زار القدس سنة 488هـ/1095م هاله عِظَمُ الحيوية العلمية في أروقته والمستوى الرفيع لعلمائه، مسجلا صورة مشرقة للتعايش الديني في الحضارة الإسلامية !!
فلنستمع إليه إذْ يقول في كتابه ‘العواصم من القواصم‘: “ثم خرجتُ عنهم (= أهل مصر) إلى الشام، فوردتُ البيت المقدس -طهره الله- فألفيتُ (= وجدتُ) فيه ثماني وعشرين حلقة [تعليم]، ومدرستين: إحداهما للشافعية بباب الأسباط، والأخرى للحنفية بإزاء قمامة (= كنيسة القيامة) تُعرف بمدرسة أبي عقبة. وكان فيه من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدِعة -على اختلاف طبقاتهم- كثيرٌ، ومن أحبار اليهود والنصارى.. جُمَلٌ (= أعداد) لا تُحصَى..، ونظرتُ إلى كل طائفة تناظر” الطوائف الأخرى في آرائها وأفكارها!!
وقد دفعته تلك الحيوية العلمية العظيمة لتأجيل أداء الحج الذي جاء من أجله، والبقاء في الأقصى لطلب العلم رغم ازدهار سوقه في الأقطار المجاورة بل وفي بلاده الأندلسية؛ وفي ذلك يقول في كتابه ‘قانون التأويل‘: “قلت لأبي رحمة الله عليه: إن كانت لك نية في الحج فامضِ لعزمك فإني لست برايمٍ (= مغادر) هذه البلدة حتى أعْلم علمَ مَنْ فيها وأجعل ذلك دستوراً (= دليلا إرشاديا) للعلم وسُلَّماً إلى مراقيها”!!
أريحية معرفية
ونجد ابن العربي يصف جوانب من تلك الحياة العلمية والنقاشات الدائرة في مجالسها بين المنتسبين إلى المدارس الفقهية؛ وذلك في قصة تعبِّر عن أريحية علمية قلَّ نظيرها فيما بعدُ، رواها لنا في كتابه ‘العواصم من القواصم‘.
يقول القاضي المالكي: “لقد كنتُ يوما جالسا بمدرسة الشافعي بـ”باب الأسباب“ في المسجد الأقصى، وقد انعقد على الطوائف -من الشافعية والحنفية- وهم في مجلس النظر (= المناظرة الفقهية)، فإذا سائلٌ قد وقف علينا، وخاطب صاحب المدرسة القاضي الرشيد يحيى بن مفرِّج المقدسي (ت بعد 488هـ/1095م) وكان أسَنَّ أصحاب نصر (بن إبراهيم المقدسي ت 490هـ/1097م)، فقال له: حلفتُ بالطلاق ثلاثا من امرأتي ألا آكل جوزا ثم أكلتها ناسيا [فماذا عليَّ]؟ فنظر إليهم [القاضي] وقال: ما تقولون؟ فقالت الحنفية عن بكرة أبيها: يحنث! واختلف قول الشافعية فيها؛ فتبسم القاضي الرشيد وقال له: اذهب، لا شيء عليك”!!
وكان انتظام الدراسة في الأقصى قويا في جميع الأوقات بما فيها تلك التي كانت تشهد اضطرابا أمنيا في مدينته المقدسة؛ وفي ذلك أيضا يقول ابن العربي في تفسيره ‘أحكام القرآن‘: “ورأيتُ فيه (= بيت المقدس) غريبةَ الدهر؛ وذلك أن ثائرا ثار به على واليه وامتنع فيه بالقوت، فحصره [الوالي] وحاول قتاله بالنشاب مدة، والبلد -على صغره- مستمر على حاله..، ولا بَرَزَ للحال من المسجد الأقصى معتكف، ولا انقطعت مناظرة، ولا بطل التدريس، وإنما كانت العسكرية قد تفرقت فرقتين يقتتلون”!!
كما يخبرنا ابن الجوزيّ -في ‘المنتظم‘- عن مرحلة مهمة من الحياة العلمية والصوفية للإمام أبي حامد الغزالي (ت 505هـ/1111م) قضاها في جنبات الأقصى؛ فيقول إنه خرج “من بغداد متوجها إلى بيت المقدس تاركا لتدريس النظامية! زاهدا في الدنيا..، ثم رجع إلى بلده وقد صنف كتاب ‘الإحياء‘ في هذه المدة”.
بل إنه نُسب إلى الغزالي موضعٌ بالقدس مارس فيه التدريس والتربية؛ فقد قال العُليمي إنه “انتقل إلى بيت المقدس مجتهدا في العبادة والطاعة، وزيارة المشاهد والمواضع العظيمة، وأخذ في التصانيف المشهورة ببيت المقدس، فيقال: إنه صنَّف في القدس [كتابه]: ‘إحياء علوم الدين‘، وأقام بالزاوية التي على باب الرحمة المعروفة قبل ذلك بـ‘الناصرية‘ شرقي بيت المقدس، فسُميت بالغزالية نسبةً إليه”.
وإذا كانت رواية العليمي تقدّم الأقصى باعتباره مهد ولادة أهم كتب الإمام الغزالي وأكثرها تأثيرا في تاريخ المسلمين العلمي والتربوي، لما ترتب عليه من نشأة لتيار الاندماج العلمي في حياة المسلمين ؛ فإننا نجد أن الأقصى كان أيضا منطلقا لنشر أحد أهم المذاهب الفقهية الباقية وهو المذهب الحنبلي.
فقد وصل هذا المذهب من العراق إلى الشام -في النصف الثاني مع القرن الخامس/الحادي عشر الميلادي- بواسطة الإمام عبد الواحد الشيرازي (ت 486هـ/1093م) الذي “قَدِم الشام فسكن ببيت المقدس فنشر مذهب الإمام أحمد فيما حوله، ثم أقام بدمشق فنشر المذهب وتخرج به الأصحاب”؛ حسب ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ/1393م) في ‘ذيل طبقات الحنابلة‘.
مدارس منوعة
لعل الأقصى كان كذلك المحضن الشامي الأول للمدارس الفقهية بمعناها المؤسسي ؛ كما نراه في “المدرسة الصلاحية” التي لم تكن حقيقة من تأسيس صلاح الدين الأيوبي، بدليل ورود ذكرها في النص المتقدم لابن العربي باسم “المدرسة الشافعية” وبجانبها “المدرسة الحنفية”؛ وذلك قبل عصر صلاح الدين بقرن كامل!
وفي أحد النصوص النادرة في رصدها لنشأة الوقف التعليمي الشخصي وخاصة في القدس؛ يفيدنا ابن العربي -في ‘سراج المريدين‘- بأن الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي -المتقدم ذكْره- رصَد وقفاً بالقدس لهذه المدرسة؛ إذْ كانت له داران “فحبس إحدى داريه على الطلبة مع معظم ماله، وجعل النظر فيها إلى يحيى بن مفرج شيخ أصحابه، وشرط أن نصيبه منها كأنصبائهم”.
أما ابن واصل الحموي (ت 696هـ/1297م) فيقول -في ‘مفرِّج الكروب‘- إن هذه “المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بـ”صند حنه” (= سانت حنة/القديسة حنة) يذكرون أن فيها قبر حنة أم مريم عليها السلام، ثم صارت في الإسلام ”دار علم” قبل أن يملك الفرنج القدس”.
ثم تحدث الحموي عن التقلبات التاريخية التي مرت بها هذه المدرسة؛ فقال إنه “كان يدرس بها العَلَم الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي قُبيل أخذ الفرنج للقدس، ثم لما ملك الفرنج القدس سنة اثنين وتسعين وأربعمئة (492هـ/1099م) أعادوها كنيسة كما كانت قبل الإسلام، فلما فتح السلطان [صلاح الدين] القدس أعادها مدرسة [للشافعية] ووقف عليها وُقوفا (= أوقافاً) جليلة، وفوّض تدريسها ووقْفَها إلى القاضي بهاء الدين بن شداد الموصلي (ت 632هـ/1234م)، وتولاها [بعده] جماعة من الفقهاء”.
ولم تلبث “المدرسة الصلاحيّة” أن تحوّلت منارةً علميّة على مستوى العالم الإسلاميّ، حين أصبحت أهم الروافع العلمية المقدسية للحياة العلمية بأروقة المسجد الأقصى. وفي عهد الدولة المملوكية كانت مشيختُها تُعيَّن بمرسومٍ من السلطان بالقاهرة، وبذلك أضحت “وظيفة مشيختها من الوظائف السَّنِية (= الرفيعة) بمملكة الإسلام”؛ حسب العُليمي.
تولى مشيخة “المدرسة الصلاحيّة” عبر الزمان قومٌ من أكابر الفقهاء والمحدثين ومشاهيرهم، وتفيد قصة أوردها ابن شاهين المَلَطيّ (ت 920هـ/1514م) -في ‘نيل الأمل‘ ضمن وقائع سنة 842هـ/1438م- أن العادة جرت بأن يستمرُّ شيخ “المدرسة الصلاحيّة” في منصبه حتى وفاته؛ كما هو العرف اليوم في منصب “مشيخة الأزهر” بمصر.
احتفاء رسمي
وبعد المدرسة الصلاحية في الأهمية العلمية والمكانة المحورية في رفْد الحياة العلمية بأروقة الأقصى؛ تأتي “المدرسة الأشرفية” التي بناها السلطان المملوكي الأشرف قايِتْباي (ت 901هـ/1495م) سنة 887هـ/1482م، وكانت آية في الجمال وحسن البناء “في المسجد الأقصى الشريف وهي آخر مدرسة بنيت فيه” حتى مطلع القرن العاشر الهجري/الـ16 الميلادي؛ طبقا للعليمي.
وقد أفاض العُليميّ في وصف بنائها ومحاسنها، ثم قال: “ومن أعظم محاسنها كونها في هذه البقعة الشريفة، ولو بُنيت في غير هذا المحل لم يكن عليها الرونق الموجود عليها ببنائها [فيه]، فإن الناس كانوا يقولون قديما: مسجد بيت المقدس به جوهرتان هما: قبة الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة؛ قلتُ (= العليمي): وهذه المدرسة صارت جوهرة ثالثة، فإنها من العجائب في حسن المنظر ولطف الهيئة”!! وكلمة العُليمي هذه بديعة جدًّا، مؤدّاها: إن كل جميل هو في القدس أجمل!
وكان أمر مشيخة “المدرسة الأشرفية” بيد السلطان الذي أسسها، فكان يرسل مبعوثين رسميين رفيعي المستوى لمطالعة حسن سيرها؛ إذْ يفيدنا المَلَطي بأنه في سنة 890هـ/1485م “قرّر في مشيخة مدرسة السلطان بالبيت المقدس العلاّمة الكمال ابن أبي شريف (ت 906هـ/1500م)، وعُيّن [قاضي القاهرة] أبو البقاء الجيعان (ت 930هـ/1524م)، و[الأمير] جان بلاط (ت 906هـ/1500م) للسفر إلى القدس لأجل تقرير أحوال المدرسة المذكورة وعمل مصالحها”!
يُعرِّف العُليمي -في ‘الأنس الجليل‘- بنحو أربعين مدرسة أقيمت في محيط المسجد الأقصى الملاصق له، سوى المدارس المقدسية الأخرى غير المجاورة له. ورغم أن المدرستين الكبرييْن السابقتين (الصلاحية والأشرفية) كانتا شافعيتيْ المذهب، انسجاما مع الانتماء المذهبي الرسمي لسلاطين الدولة الأيوبية ثم المملوكية؛ فإنه كان للمذاهب الأخرى حضورُها العلمي في أروقة المسجد الأقصى، وأنشئت مدارسُها المذهبية في أكنافه المقدسية.
فقد كان لأصحاب المذهب الحنفي “المدرسة المعظَّمية”، التي تُنسب إلى واقفها أحدِ السلاطين الأيوبيين كان من فئة العلماء الأمراء؛ وهو ملِك دمشق العالِم: المعظَّم عيسى ابن العادل (ت 624هـ/1227م) الذي فضّل ألا يأخذ النسخة المذهبية ذاتها التي كان ينتمي إليها أبناء بيته الأيوبي، وهي المذهب الشافعي؛ بل اختار أن يكون فقيها حنفيا متبحرا في مذهبه “حتى تأهَّل للفتيا” فيه رغم أعباء السلطة؛ طبقا للذهبي في ‘السِّيَر‘.
وقد حدد لنا العليمي المكان الذي كانت تقع فيه “المدرسة المعظمية” وتاريخ إنشائها؛ فقال إنها أقيمت “مقابل باب شرف الأنبياء المعروف بباب الدَّوَادارية (يسمَّى اليوم باب العتم وباب الملك فيصل)، [وكان] تاريخ وقفها في السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 606هـ (= 1209م)”.
ريادة مستحقة
وترجم العُليمي لأساتذتها وخاصة من تولى منهم مشيختها؛ فذكر فيهم قاضي القضاة خير الدين خليل بن عيسى البابَرْتي الحنفي (ت 801هـ/1398م)، الذي وصفه بأنه “الإمام العلامة، كان من أهل العلم والدين قدم من بلاده واختار الإقامة ببيت المقدس، وولي قضاء القدس من الملك الظاهر بَرْقُوق (ت 801هـ/1398م) في سنة 784هـ (= 1382م)، وهو أول من ولي قضاء الحنفية بالقدس الشريف بعد الفتح الصلاحي، ثم ولي تدريس المعظمية”.
أما المالكية، فكانت لهم “المدرسة الأفضلية”، وقد عرّف بها العُليمي قائلا: “المدرسة الأفضلية: وتُعرف قديما بحارة المغاربة، [وهي من] وقْف الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي ابن الملك صلاح الدين (الأيوبي ت 622هـ/1225م)، وقَفَها على فقهاء المالكية بالقدس الشريف (نحو سنة 590هـ/1194م)، ووقف أيضا حارة المغاربة على طائفة المغاربة على اختلاف أجناسهم ذكورهم وإناثهم”.
ويبدو أن الملك الأفضل هذا كان أحد أفذاذ الأمراء العلماء المحبين لنشر العلم والدفاع عن المقدسات؛ ولذا جاء في ترجمته عند ابن واصل الحموي أنه “كان مستجمعا لفضائل ومناقب تفرقت في كثير من الملوك”! كما يذكر العُليمي أنه كان معروفا ببذله “أنواعا من البر والخير، ووضَع الأسلحة برسم المجاهدين في سبيل الله” للدفاع عن القدس والأقصى!!
وللحنابلة مدرستهم التي كانت تُعرف باسمهم وأنشئت سنة 781هـ/1379م، وقد ذكرها العُليمي مبينا موقعها فقال: “المدرسة الحنبلية بباب الحديد [غربي الأقصى]، واقفها الأمير بَيْدَمُر (الخوارزمي ت بعد 781هـ/1379م) نائب الشام”.
ولعل من الطريف ذكر أن الشيخ الشافعيّ إبراهيم بن علي الإسْعَردي الصوفي الزاهد (ت 887هـ/1482م) تولَّى مشيخة هذه المدرسة الحنبلية رغم الاختلاف المذهبي بينهما؛ فقد ذكر العُليمي في ترجمته أنّه “قدم إلى بيت المقدس واستوطنه، وقرره الملك الظاهر جُقْمُق (ت 857هـ/1453م) في المدرسة الحنبلية بباب الحديد”!!
وبالنظر إلى هذا التاريخ العلمي الزاهر الزاخر؛ لا نبالغ إن قلنا إن المكانة العلمية والروحية لمدارس المسجد الأقصى ومشيخاته، كانت تؤهلها لأن ترثها جامعةٌ حديثة عريقةٌ على غرار الأزهر والزيتونة والقرويين، لكن حال دون ذلك تسلّطُ المحتلين عليه منذ ثلاثينيات القرن الـ14 الهجري/بدايات القرن الـ20 الميلادي، وهي الفترة التي شهدت تأسيس الجامعات الحديثة في بلادنا.
معتكَف دائم
كان من مظاهر عُلوّ مكانة القدس في قلوب المسلمين أن كثيرًا منهم اختارها موطنًا تاركا أهله وبلاده، وأقام مستأنسًا بجوار المسجد الأقصى المبارك طالبا للعلم، أو راغبا في التزكية، أو ناشرا لكليهما، أو مرابطا في ثغره للدفاع عنه؛ ولم يكن ذلك في الحقيقة إلا وجها آخر من أوجه الحياة العلمية فيه، فالعلم والتزكية صنوان متلازمان.
فهذا الإمام ابن العربي المالكي (ت 543هـ/1148م) يقول -في ‘سراج المريدين‘- واصفا هذه “العمارة الرباطية” لتلك الرحاب المباركة: “لقد عبدناه في المسجد الأقصى -طهره الله- ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال؛ مع أمم من العابدين والعاكفين والعالِمين، نحوا من ثلاثة آلاف معلومين، حصدتهم السيوفُ في غداة واحدة!! فأيُّ عيش بعدهم يطيب؟ أم أيُّ أمل يُسْتأنَف؟!”.
ويذكر -في ‘العواصم من القواصم‘- أنه حين سقطت القدس في أيدي القوات الصليبية “محت كلمة الإسلام عن المسجد الأقصى، وقتل فيه -في غداة الجمعة لاثنيْ عشر بقيت لشعبان سنة اثنين وتسعين وأربعمئة- ثلاثة آلاف ما بين عابد وعالم، ذكر وأنثى، ومعتكف من مشهور الحالة ومذكور بالديانة، وفيها قتلت العالمة الشيرازية -بقبة السلسلة- في جملة النساء”!!
وإذا كانت هذه الثلاثة آلاف مجاور إنما هي ممن ينطبق عليهم وصف “مشهور الحالة ومذكور بالديانة”؛ فكم سيكون عدد غيرهم من المجهولين والمغمورين ممن استشهدوا أو بقوا سالمين؟! ولذلك لا يُحصى عدد مَنْ ترجم لهم المؤرخون -وخاصة العُليمي في ‘الأنس الجليل‘- ممن آثروا سكنى القدس على بلادهم، فمكثوا بها حتى توفوا ودفنوا في مقبرتها الشهيرة المسمّاة “ماملّا”.
ويفيدنا ابن العربي أيضا بأبرز أماكن المرابطة في الأقصى التي كان هؤلاء العلماء والعباد يركنون إليها؛ فيقول: “وأما المسجد الأقصى فكان منهم (= المجاورين) مملوءا: كان بالسكينة (= باب السكينة)، وبمحراب زكرياء، وبباب التوبة والرحمة، وبمهد عيسى، وبقبة السلسلة، وبقبة النبي ﷺ، وبقبة جبريل عليه السلام، وبالصخرة المقدسة، وبمحراب داود، وبباب حطة، وبباب الأسباط؛ بكل واحد رجل عالم منقطع إلى الله، لم يخرج من المسجد منذ دخل إليه حتى استشهد به”!!
رباطية صامدة
وكان العلماء يذكرون المُقام في بيت المقدس والمجاورة بالمسجد الأقصى ضمن مناقب العلماء وفضائل العُبّاد؛ فمثلا حين ترجم الإمام السخاوي (ت 902هـ/1496م) -في ‘الضوء اللامع‘- للعلامة نصر المغربي المالكي (ت 826هـ/1423م) نعته بأنه “نزيل بيت المقدس”، ويقول إنه “قدِمه (= القدس) من بلاده فأقام به قريبا من عشرين سنة على قدم التجرد والاشتغال بالعلوم والعبادة، قانعًا باليسير إلى أن مات ودفن هناك”، وكان موصوفًا “بالعلم والفضل والزهد”.
وقد يأتي أحدهم إلى القدس وهو شاب يطلب العلم فيستوطنها حتى يموت ويدفن فيها، ويكون له من المكانة والهيبة ما يجعلُ السلاطين والأمراء تزوره في بيته، ومن هؤلاء “الإمام القدوة الزاهد العابد.. أبو بكر بن علي.. الشيباني الموصلي.. الشافعي (ت 797هـ/1395م)..، قدم من الموصل وهو شاب وعلا ذكْرُه، وقد زاره السلطان برقوق في منزله بالأمينية بجوار سور المسجد الأقصى”.
وكما رأينا في شهادة القاضي ابن العربي المالكي؛ فإن طلب الجوار بالأقصى لم يكن مقتصرا على الرجال، بل كان مقصدا شائعا في الصالحات من النساء؛ ويفيدنا هو بوجود مئات المرابطات اللاتي كُنَّ منتظماتٍ في شبه “تنظيم رباطي” يتألف من زهاء ألف امرأة ويتبعن فيه لقيادة علمية نسوية واحدة ، وقد تحولن إلى مدافعات شرسات عن الأقصى حين اقتحم ساحاته الصليبيون حتى استشهدن جميعا وهن صابرات صامدات!!
يقول ابن العربي في ‘سراج المريدين‘: “لقد كان في بيت المقدس نسوة يُفْخَرُ بهنّ على الأزمنة؛ يَلْتَفِفْنَ على العالمة الشيرازية: فقيهة واعظة متعبدة متبتّلة؛ فلما دخل الروم بيت المقدس يوم الجمعة لاثنتيْ عشرة ليلة بقيت لشعبان من سنة ثنتين وتسعين وأربعمئة (492هـ/1099م) لجأت بهن أجمعين إلى المسجد الأقصى، وجلسن في قبة السلسلة..، فلما غشيتهن الروم قمن إليهم بالسب ورمي التراب في وجوههن، فحصدوهن بالسيوف وأنزلوا بهن الحتوف. قال لي من عاين ذلك وهو في سطح المسجد الأقصى: كن قريبا من ألف امرأة”!!
ولعل قائلًا يقول: لماذا يختارُ البلخيُّ أو المغربيّ أو المصريّ أو الشامي أو العراقي أن يأتي الواحد منهم من أقصى الأرض أو أدناها ليستقرّ في بيت المقدس بدلًا من المجاورة بمكة والمدينة، وهو سؤالٌ وجيه، يمكن أن نجد إجابته في عبارة ترد أحيانا في تراجم العلماء المجاورين، فتصف أحدهم بأنه جاور الأقصى “بنية الرّباط” للجهاد في أكنافه وصدّ الغزاة عنه.
محن كبرى
اشتهرت القُدس -مستمدةً ذلك من موقع المسجد الأقصى في قلبها- بمنزلتها الدينية والعلمية، ومع ذلك فلم يخلُ تاريخها من وضعيّة سياسية مميزة كادت تدفع الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (ت 99هـ/719م) إلى اتخاذها عاصمةً للخلافة الإسلامية برمّتها!!
فمؤرخ الأقصى شمس الدين الأسيوطي يروي -في ‘إتحاف الأخِصّا‘- أن الخليفة سليمان “أتى بيت المقدس وأتته الوفود بالبيعة..، فكان يجلس في قبة في صحن مسجد بيت المقدس مما يلي الصخرة… ويبسط البُسُط (= الفُرُش) بين يدي قبّته عليها النمارق (= الوسائد) والكراسي، فيجلس ويأذن للناس فيجلسون عل الكراسي والوسائد، وإلى جانبه الأموال، وكُتاب الدواوين (= الوزراء)، وقد هَمَّ بالإقامة ببيت المقدس واتخاذها منزلا، وجمْع الأموال والناس به”!!
ولئن كان أمرُ اتخاذ بيت المقدس عاصمة لم يتمّ فعلاً؛ فإنّ المسلمين جعلوه عاصمة عزّتهم وكرامتهم، واعتبروا حاله مقياسًا يقيسون به عزّهم وشرفهم، حتى إنه في سنة 452هـ/1061م حدث أن “سقطت قبة الصخرة فتطيّر المسلمون من ذلك”! حسب أحمد بن يوسف القرماني (ت 1019هـ/1610م) في كتابه ‘أخبار الدول‘.
ولم يكن خوفهم ذاك بعيدًا من الواقع؛ إذْ احتَلّ الصليبيون القُدسَ بعدها بأقل من نصف قرن، وألحقوا بأهلها من التقتيل والتنكيل ما صدم حتى المؤرخين الصليبيين أنفسهم الذين سنكتفي هنا بعرض بعض شهاداتهم بشأن ممارسات بني جلدتهم بحق سكان القدس ومقدساتها، التي ما فتئت هدفا للاستهداف الأجنبي ونقطة صدام ديني دائم مع الحضارة الغربية.
ينقل مؤرخ الحضارات الأميركي وِيلْ ديورانت (ت 1402هـ/1981م) -في ‘قصة الحضارة‘- عن أحدهم: “يقول القس ريمند الإجيلي (ت بعد 492هـ/1099م) شاهد العيان: وشاهدنا أشياء عجيبة، إذ قُطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين وقتل غيرهم رميا بالسهام، أو أرغِموا على أن يُلقوا أنفسهم من فوق الأبراج، وظل بعضهم الآخر يعذَّبون عدة أيام، ثم أحرِقوا في النار!! وكنتَ ترى في الشوارع أكوامَ الرؤوس والأيدي والأقدام! وكان الإنسان أينما سار فوق جواده يسير بين جثث الرجال والخيل”!!
ويضيف ديورانت: “ويروي غيره (= ريمند الإجيلي) من المعاصرين تفاصيل أدق من هذه وأوفى؛ [فـ]ـيقولون إن النساء كُنَّ يُقتلن طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرُّضّع يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم، ويقذف بهم من فوق الأسوار، أو تهشّم رؤوسهم بدقها بالعَمَد، وذُبح السبعون ألفا من المسلمين الذين بقوا في المدينة، أما اليهود الذين بقوا أحياء فقد سيقوا إلى كنيس لهم، وأشعلت فيهم النار وهم أحياء”!!
عنوان للمجد
وتصديقا لكلام هذا الشاهد الصليبي؛ يجدر التذكير برواية ابن العربي المتقدمة عن قتل الصليبيين “العالمة الشيرازية” ونحو ألف من تلميذاتها المرابطات بالأقصى، وثلاثة آلاف من العلماء والصُّلَحاء كانوا زينة أروقته وأكنافه! وكذلك مقولة المؤرخ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م) الذائعة: “قَتل الفرنجُ بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا، منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزهادهم، ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف”!!
وأما عن تدنيس الصليبيين للأقصى ومرفقاته؛ فحسبنا أن نمثّل له بما فعلوه في احتلالهم الثالث للقدس سنة 637هـ/1239م، على أنه كان أخف درجة مما فعلوه في احتلالهم الأول، رغم أنه في فترات الاحتلال كلها تعطلت فيه صلوات الجُمع والجماعات.
وعندنا فيما لحق بالأقصى من تدنيس صليبي شهادة موثقة لمؤرخ عاصر تلك الحقبة هو ابن واصل الحموي، الذي يقول -في ‘مفرِّج الكروب‘- عن زيارته القدس أيامها سنة 641هـ/1243م: “دخلتُ البيت المقدس ورأيتُ الرهبان والقُسوس على الصخرة المقدسة، وعليها قناني الخمر برَسْم (= لأجْل) القربان، ودخلت الجامع الأقصى وفيه جرَس معلَّق، وأُبطِل (= أوقِفَ) بالحرم الشريف الأذانُ والإقامة، وأُعلِن فيه بالكفر”!!
ومنذ وقتٍ قديم؛ عُدّ احتلال بيت المقدس عارًا في حقّ المسلمين -إذا سكتوا عليه- ولا سيّما حكامهم الذين أدى تقاتلهم وتخاذلهم إلى احتلاله ثلاث مرات ، اثنتان منهما بالتسليم الطوعي للمحتلين وتمّتا خلال عقد واحد سنتيْ: 626هـ/1229م و637هـ/1239م. ويقول المؤرخ ابن الأثير معلقا على إحداها وأثرها في نفوس المسلمين حينها: “وتسلّم الفرنج البيت المقدس، واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه، ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه؛ يسر الله فتحه وعوده إلى المسلمين”!
وقد ذكر المؤرخ الأديب الصفدي -في ‘الوافي بالوفيات‘- قصة بيتين شاع أمرهما بين الناس “لما خرب القدس”، وكأنهما قيلا على لسان هذه زهرة المدن الأسلامية بعد مكة والمدينة:
إن يكن بالشآم قلَّ نصيري ** ثم خُرِّبتُ واستمرّ هُلوكي
فلقد أثبتَ الغداةَ خرابي ** سِمَةَ العارِ في جِباهِ الملوكِ!!
ونجد هذا المعنى -الذي يقرن بين ضياع الأقصى وإلحاق العار بالمسلمين- أوضح وأجلى في القصيدة الشهيرة للشاعر العالِم أبي المظفَّر الأبِيوَردي (ت 507هـ/1113م) التي نظمها وهو شاب عند احتلال القدس، مستنهضًا المسلمين عربًا وعجمًا لتحريرها، فكان مما قاله فيها وفقا لابن الجوزي في ‘المنتظم‘:
وتلك حروبٌ من يَغِبْ عن غمارها ** ليسلمَ، يقرعْ بعدَها سِنَّ نادمِ!!
أرى أمتي لا يشرعون إلى العِدى ** رماحَهُمُ، والدينُ واهي الدعائمِ
ويجتنبون الثأر خوفًا من الردى ** ولا يحسبون العارَ ضربةَ لازمِ
وليتهم إن لم يذودوا حميّةً ** عن الدينِ ضنوا غيرةً بالمحارم
وإنْ زهدوا في الأجر إذ حمي الوغى ** فهلّا أَتَوْهُ رغبةً في المغانم!
رعاية متجددة
ولذا حفظ التاريخ أسماء السلاطين الذين تشرّفوا بتحرير الأقصى وعلى رأسهم السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، الذي جعل من الأقصى نقطة ارتكاز لمشروع تحرير المنطقة كلها -وليس القدس وحدها- من الصليبيين، فصار له “بذلك الذكْر الجميل على تقضي الأعصار وممرّ الأيام”؛ وفقا لابن الأثير.
وقد ازدادت مكانة الأقصى رسوخا في قلوب المسلمين بعد تحريره بأحد أهم انتصارات المسلمين التاريخية ، وظهر ذلك من أول لحظة استعادوه فيها حين جاء في “خطبة الفتح” التي ألقاها قاضي القضاة محيي الدين ابن الزكي الشافعي (ت 598هـ/1105م)، وكانت بمحضر صلاح الدين في أول جمعة أقيمت بالمسجد الأقصى بعد تحريره؛ فوصفه فيها بأنه “أُولـ[ـى] القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه”!! ومن ثمّ برع من بعده خلفاؤه من “ملوك بني أيوب في فعل الآثار الجميلة بالمسجد الأقصى”؛ حسب العليمي.
وذكر المؤرخون أيضا سعي السلاطين المماليك _الذين ورثوا الدولة الأيوبية للعناية بإدارته ومرافقه، وربط شرعية حكمهم بخدمة أهله والدفاع عنه، وترسيخ ذلك في وعي الجماهير؛ حتى إن عادة قراءة المراسيم السلطانية بالمسجد الأقصى كانت متأصلة بحيث عُيِّن لها موظفٌ خاصّ بها، مثل الشيخ شمس الدين محمد بن محمد المقرئ المؤذّن الشافعي (ت 875هـ/1470م) الذي حكى العليمي أنه كان “يقرأ المراسيم الشريفة الواردة من السلطان على دكة المسجد الأقصى”.
بل إنهم كانوا إذا أصدروا قرارات عادلة نقشوها في الرخام وألصقوها على جدرانه تأكيدا لأهميتها عندهم وقوة إلزامها لهم ولولاتهم وللرعية. ومن ذلك ما أورده العُليمي من أن السلطان المملوكي برقوق “أبطل المكوس (= الضرائب) والمظالم والرسوم التي أحدثها النواب قبله بالقدس الشريف، ونقش بذلك رُخامةً وألصقت على باب الصخرة من جهة الغرب”.
وكذلك فعل ابنه وخليفته في الحكم الناصر فرَج (ت 815هـ/1412م) الذي حرص على فصل إدارة المقدسات بالأقصى عن اختصاصات والي السلطة بالقدس، فكان “من جملة ما رسَمَ (= أمَرَ) به بالقدس الشريف أنّ نائب القدس (= الوالي) لا يكون ‘ناظر الحرمين الشريفين‘ (= حرم الأقصى والحرم الإبراهيمي بالخليل)، ولا يتكلم على النظر بالجملة الكافية، ونُقش بذلك بلاطة وأُلصِقتْ بحائط باب السلسلة عن يمنة الداخل من الباب”!!
وفي العهد العثماني عاشت القدس والأقصى أحد أعزّ عصورها على الإطلاق؛ فبعد ضمّ السلطان العثماني سليم الأول (ت 926هـ/1520م) منطقة الشام إلى دولته زار القدس -وهو في طريقه إلى مصر- أواخر سنة 922هـ/1517م، وهناك استقبله “علماء المدينة وأتقياؤها وحكماؤها وشيوخ العربان فيها، وسلّموه مفاتيح المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، فسجد لله حامدا وقال: “الحمد لله! فأنا اليوم حامي القبلة الأولى”!!…، وكان يبكي في المسجد الأقصى بكاء حارا”!! حسب د. أحمد حسين الجبوري في كتابه ‘القدس في العهد العثماني (1516-1640م)‘.
أما خليفته السلطان سليمان القانوني (ت 974هـ/1566م)؛ فيقول الجبوري إنه في ظل حكمه “نعمتْ القدسُ بأزهى أيامها في العهد العثماني…، [إذْ] نالت.. اهتماما فائقا وقام بأعمال تعمير ضخمة في القدس..؛ ومن الأعمال المهمة للسلطان سليمان القانوني تجديد بناء قبة الصخرة المشرفة سنة 949هـ/1552م”.
ويضيف أن القانوني تقدَّم خطوة أخرى في منح القدس والأقصى مكانة متميزة، حين أشرك مؤسسة الفتوى بها في ترتيبات حمايتها؛ حيث أصدر “في سنة 944هـ/1537م فرماناً (= قراراً) بمنع الإنكشارية (= العساكر العثمانية) من الدخول إلى القدس، وأوكل مسألة الأمن وضبطه إلى مفرزة تم اختيارها من عناصر إنكشارية متميزة، وقد عهد إلى مفتي القدس بانتقائها”!!