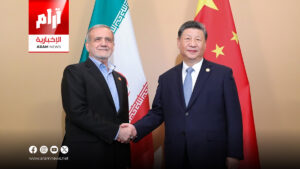عالم المكتبات في الحضارة الإسلامية

“أعظم خزائن الكتب في الإسلام ثلاث خزائن: إحداها، خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد، فكان فيها من الكتب ما لا يُحصى كثرة ولا يقوم عليه نفاسة…؛ الثانية، خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر، وكانت من أعظم الخزائن وأكثرها جمعا للكتب النفيسة من جميع العلوم…؛ الثالثة، خزانة خلفاء بني أمية بالأندلس، وكانت من أجلّ خزائن الكتب أيضا”!!
هذا نص نفيس أورده شهاب الدين القَلْقَشَنْدي (ت 821هـ/1418م) -في كتابه ‘صُبح الأعْشَى في صناعة الإنشا‘- متحدثا عن ثلاثة فضاءات سياسية متنافسة على شرعية “الخلافة” وتمثيل المسلمين، عبر توظيف سعيها لحفظ علومهم والعناية بتراثهم؛ فكان ميدان هذا التنافس هو المسابقة إلى إقامة المكتبات المركزية العامة، التي حرصت كل من تلك الدول الثلاث على إنشائها لتكون واجهتَها الثقافية المعبِّرة عما يسود داخلها من ازدهار عمراني وتطور حضاري، ومرآتَها العاكسة لمدى وفائها بالتزاماتها في ميدان خدمة العلم وإجلال العلماء.
كان تقليد إنشاء المكتبات في الحضارة الإسلامية إحدى ثمار مسار معرفي طويل بدأ مع عملية جمع القرآن العظيم وتكثير نسخه، ثم تلا ذلك تدوينُ المرويات من الأحاديث النبوية، وحول هذين الأصلين تولّدت المعارف وتفرعت العلوم فأُودِعت في بطون الكتب حفظا لمضمونها وتيسيرا لتداولها بين الأجيال، ثم من تكاثر الكتب -في شتى الفنون- تكوّنت المكتبات في منازل العلماء والأمراء. فقد كانت عناية الخلفاء الراشدين بالقرآن (جَمْعاً ونَسْخاً) ملهمة للخلفاء والسلاطين بأن صناعة الكتب وإنشاء المكتبات داخلان ضمن أولويات وظائف السلطة في الإسلام، بل وأحد متممات مشروعية الحاكم السياسية بوصف المكتبات نتاجا لتلك الرعاية وثمرة للحركة المعرفية في زمن الراشدين.
ولارتباط المكتبات العامة -في أصلها- بالسلاطين صارت مضربا للمثل لما كانت عليه عادة من ضخامة وفخامة؛ فقد كان يوصف العالِم أو القارئ صاحب المكتبة الكبيرة بأنه صاحب “خزانة مُلوكية”!! وكذلك كان حال رجال الدول المتنفذين في أقدار السياسات والممالك؛ إذْ يحدثنا التاريخ بأن وراء الكثير من عظماء الساسة والوزراء مكتبةً عظيمة، فمثلا الوزير البويهي الصاحب ابن عَبَّاد (ت 385هـ/996م) كان يمتلك مكتبة ضخمة اشتملت على مئتين وستة آلاف مجلد بحسب ما جاء ذكره ياقوت الحموي (ت 626هـ/1229م) في ‘معجم الأدباء‘.
كما اقتنى الأديب الفاضل البَيْسَاني (ت 596هـ/1200م) -الذي كان مستشارا وكاتبا للسلطان صلاح الدين الأيوبي (ت 589هـ/1193م)- زهاءَ مئة ألف كتاب!! وهو ما يعطينا انطباعا بالغ الدلالة عن سمات الرجال المتنفذين في العصور الزاهرة للحضارة العربية الإسلامية. ولم يغفل السلطان صلاح الدين التنبه على الأثر العلمي لهذه المكتبة في الحياة السياسية لمستشاره، بل عبَّر عن ذلك بإيجاز بليغ قائلا: “لا تظنّوا أنّي مَلكتُ البلاد بسيوفكم، بل بقلم الفاضل”؛ وفقا للمؤرخ ابن تَغْري بَرْدي (ت 874هـ/1470م) في ‘النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة’.
ووفقا لما تكشفه هذه المقالة وتبرهن عليه؛ فإن حضور المكتبة -في القصور والبيوت أولا ثم في المساجد والمكتبات العامة ثم المدارس لاحقا- ظل سمةً دائمة ومعْلمة بارزة في تاريخ المسلمين، حتى وصل الأمر إلى التباهي والوجاهة الاجتماعية حين باتت خزائن الكتب معبِّرة عن الشرف والمكانة، ومن مكونات اللمسة الجمالية في المكان فزينت رفوف المكتبات بيوتهم، وكان أهم ما يميز تلك المكتبات هو تنوع محتوياتها وغناها بمختلف مصادر المعرفة.
ثم وصل المسلمون إلى مستوى متقدم في إدارة وأرشفة وتصنيف المكتبات، وفهرسة محتوياتها حسب حقول المعرفة وتخصصاتها الموضوعية، ونُظُم الاستفادة منها عبر تهيئة قاعات خاصة لمطالعة أسفارها، ووضْع القواعد المنظمة لاستعارة الكتب، وفرض الغرامات المالية التي تترتب على إضاعتها أو إتلافها.
لقد كانت وظيفة “خازن الكتب” من الوظائف المرموقة في الدولة وأقدمها وجودا، وكان يضطلع بمسؤولياتها الجِلّة من الفقهاء والمفكرين في العصور الإسلامية. ولئن أخذت المكتبات في الحضارة الإسلامية طابع المكتبة الحديثة من حيث المؤسسية؛ فإنها منذ الصدر الأول كانت حريصة على ألا تنحصر في فضاء علوم الشريعة فحسب بل غطت شتى ميادين المعارف والآداب والفلسفات، بدليل ما احتوته خزائنها الخاصة والعامة من مؤلفات متنوعة، وترجمات دقيقة لفلسفات ومعارف الحضارات القديمة.
بل وصل الأمر إلى أن ينتهج الخليفة العباسي المأمون (ت 218هـ/833م) نوعا مما يُعْرف الآن بـ”الدبلوماسية الثقافية”؛ فتواصل مع ملوك الروم والهند طالبا منهم إمداد المكتبات العباسية بالذخائر المعرفية الموجودة عندهم، كما وفّر المخصصات المالية الضخمة لترجمة هذه الذخائر وإتاحتها للقراءة العامة.
اهتمام مبكر
كان الأمراء والملوك في الصدر الأوّل يتنافسون في اقتناء الكتب وتأسيس خزائنها، وتقريب العلماء بمختلف فنونهم وتوجهاتهم وتشجيعهم على الكتابة والتأليف ونشر العلم، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من تعزيز شرعية الدولة القائمة؛ علاوة على أنّ الحكام -بدءا من الملوك والأمراء الأمويين- أبدوْا رغبة مبكرة في نقل علوم الآخرين بالترجمة، لرفد خزائن كتبهم بتصانيف الثقافات الأخرى.
وثمة نصوص متناثرة -في كتب التراجم والطبقات- تلمّح كثيراً إلى وجود مبكر لـ”خزائن الكتب”؛ ومن تلك النصوص ما ذكره جمال الدين القِفْطي (ت 646هـ/1248م) -في ‘إخبار العلماء بأخبار الحكماء‘- من أن الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ/720م) لما ذُكر له “كتاب أهرن القس” في علم الطب أراد الاطلاع عليه فـ”وجده.. في خزائن الكتب، وأمر بإخراجه ووضعه في مصلاه، واستخار الله في إخراجه للمسلمين ليُنتفع به، فلما تم له في ذلك أربعون يوما أخرجه إلى الناس وبثّه في أيديهم”.
وهذا المصنّف الطبي -الذي ينسب إلى أهرن بن أعين وهو طبيب إسكندري عاش في القرن الخامس الميلادي- يعتبر “أول كتاب نُقِل (= تُرجم) إلى العربية”؛ طبقا لعلامة الشام محمد كرد علي (ت 1372هـ/1953م) في مقال له بعنوان “النَّقْل والنَّقَلَة” نشره في مجلة ‘المقتبس‘ (العدد 12 – بتاريخ: 15/1/1907).
ويذكر ابن عبد البر الأندلسي (ت 463هـ/1071م) -في ‘جامع بيان العلم وفضله‘- عن الزهري (ت 124هـ/743م) قوله: “أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً”. ونلحظُ هنا أن الخليفة كان مهتما بكتب الطب التي كانت حينها لصيقة بالفلسفة، وفي نفس الوقت كان معتنيا بجمع السنن المرتبطة بالتفقه في الدين، فلم ير تعارضاً بينهما كما تضخم فيما بعدُ.
إلا أنه في عهد الأمويين عموماً ظلت أغلبية الكتب في العلوم النقلية/الدينية؛ رغم أنه شهد نماذج ريادية لافتة في تأسيس المكتبات الشخصية والعامة بجانب “خزائن الكتب” المملوكة لحكام الدولة.
فياقوت الحمويّ (ت 626هـ/1229م) يفيدنا -في ‘معجم الأدباء‘- بأن الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية (ت 90هـ/710م) كان “علّامة خبيراً بالطبّ والكيمياء، شاعراً…، قيل عنه: قد علِمَ عِلْم العرب والعجم”، ويضيف ابن خلّكان (ت 681هـ/1282م) أنه “كان بصيرا بهذين العلمين (الطبّ والكيمياء) متقنا لهما، وله رسائل دالة على معرفته وبراعته…، وله فيها ثلاث رسائل” من تأليفه.
ومع انتقال الدولة إلى العباسيين سنة 132هـ/751م، وتحديدا منذ عهد المنصور (ت 158هـ/776م)؛ كانت البداية الرسمية والمنتظمة لدخول العلوم العقلية والحكمة والفلسفة. يقول حاجي خليفة في ‘كشف الظنون‘: “واعلم أنّ علوم الأوائل كانت مهجورة في عصر الأمويين. ولما ظهر آل عباس كان أول من عُني منهم بالعلوم الخليفة الثاني.. المنصور، وكان مع براعته في الفقه مقدما في علم الفلسفة.. محبا لأهلها”.
قفزة تاريخية
ويقدم لنا ابن العبري (ت 685هـ/1284م) -في ‘تاريخ مختصر الدول‘ نقلا عن القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي (ت 462هـ/1070م)- تلخيصا جيدا لتطور اهتمام العباسيين بحيازة الكتب وتحصيل العلوم؛ فيقول إنه “كان أول من عُني منهم بالعلوم الخليفة الثاني.. المنصور، وكان مع براعته في الفقه كلفا في علم الفلسفة.. ثم لما أفضت الخلافة فيهم إلى.. المأمون (ت 218هـ/833م).. تمّم ما بدأ به جده المنصور، فأقبل على طلب العلم في مواضعه، وداخل ملوك الروم وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلسفة، فبعثوا إليه منها ما حضرهم، فاستجاد لها مهرة التراجمة وكلفهم إحكام ترجمتها، فتُرجمت له على غاية ما أمكن؛ ثم حرّض الناس على قراءتها ورغّبهم في تعليمها”.
أما أن ابن خلدون (ت 808هـ/1406م) فيؤكد أن المنصور -وقد كان عالما فقيها- سبق المأمون إلى ذلك “فبعث.. إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة، فبعث إليه بكتاب أوقليدس (عالم هندسة يوناني توفي نحو 270ق.م) وبعض كتب الطبيعيات، فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفر بما بقي منها”.
وهذا يدل على أنّ حركة الترجمة وتعزيز حضور الفلسفة في الحياة العلمية -بجانب علوم الشرع- كان بعناية الدولة وملوكها العلماء، فلم تُحارَب تلك العلوم على غرار ما حدث في أوروبا في العصر الوسيط.
قفزة تاريخية
ويقدم لنا ابن العبري (ت 685هـ/1284م) -في ‘تاريخ مختصر الدول‘ نقلا عن القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي (ت 462هـ/1070م)- تلخيصا جيدا لتطور اهتمام العباسيين بحيازة الكتب وتحصيل العلوم؛ فيقول إنه “كان أول من عُني منهم بالعلوم الخليفة الثاني.. المنصور، وكان مع براعته في الفقه كلفا في علم الفلسفة.. ثم لما أفضت الخلافة فيهم إلى.. المأمون (ت 218هـ/833م).. تمّم ما بدأ به جده المنصور، فأقبل على طلب العلم في مواضعه، وداخل ملوك الروم وسألهم صلته بما لديهم من كتب الفلسفة، فبعثوا إليه منها ما حضرهم، فاستجاد لها مهرة التراجمة وكلفهم إحكام ترجمتها، فتُرجمت له على غاية ما أمكن؛ ثم حرّض الناس على قراءتها ورغّبهم في تعليمها”.
أما أن ابن خلدون (ت 808هـ/1406م) فيؤكد أن المنصور -وقد كان عالما فقيها- سبق المأمون إلى ذلك “فبعث.. إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة، فبعث إليه بكتاب أوقليدس (عالم هندسة يوناني توفي نحو 270ق.م) وبعض كتب الطبيعيات، فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفر بما بقي منها”.
وهذا يدل على أنّ حركة الترجمة وتعزيز حضور الفلسفة في الحياة العلمية -بجانب علوم الشرع- كان بعناية الدولة وملوكها العلماء، فلم تُحارَب تلك العلوم على غرار ما حدث في أوروبا في العصر الوسيط.
توظيف سياسي
لقد أصبحت خزائن الكتب تلك أحد أوجه التنافس المحموم على الشرعية الشعبية والدينية بين ثلاثةِ أنظمةِ خلافةٍ، ظهرت متزامنة في القرن الرابع في ثلاثة من أقطار العالم الإسلامي الكبرى: الأسرة العباسية ببغداد وما يتبعها من مناطق وتمثلها مكتبة مؤسسة “بيت الحكمة” التي كان من أمنائها سهل بن هارون (ت 215هـ/830م)؛ كما سبق القول.
والثانية الأسرة الفاطمية في مصر والشام وبعض الغرب الإسلامي، والتي أعلنت انتماءها إلى البيت العلوي الهاشمي وادّعت أنها صاحبة الحق في خلافة المسلمين فتلقّب حكامُها بألقاب الخلافة. وترمز لها مكتبة “دار العلم” التي نعرف من أمنائها الأديب البارع أبا الحسن علي بن محمد الشابُشْتي (ت 388هـ/999م) صاحب كتاب ‘الديارات‘؛ فقد قال قاضي القضاة المؤرخ شمس الدين ابن خلّكان (ت 681هـ/1262م) -في كتابه ‘وفيات الأعيان‘- إنه “كان أديبا فاضلا، تعلق بخدمة العزيز بن المُعِزّ العُبيدي (ت 386هـ/997م) صاحب مصر فولّاه أمر خزانة كتبه”.
وأما الأسرة الثالثة فهي العائلة الأموية الحاكمة في بلاد الأندلس وبعض مناطق الغرب الإسلامي، وكان أمراؤها أعلنوا دولتهم “خلافةً” إثر ضعف الخلافة العباسية منذ مطلع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، وتزامن ذلك مع صعود نجم “الخلافة” الفاطمية بالغرب الإسلامي. وقد أسَّست لها مكتبة تسمى “خزانة العلوم والكتب”، وقد وصلنا من أسماء أمنائها تليدُ الفتى الصقلبي (ت بعد 400هـ/1010م)، موْلَى الخليفة الأموي الحكم المستنصر (ت 366هـ/977م).
وقد نقل لنا المَقَّري التلمساني (ت 1041هـ/1631م) -في ‘نفح الطيب‘- معطيات بالغة الأهمية عن حجم خزانة كتب الأمويين هذه وكيف تكوّنت؛ فقال إن المستنصر هذا “كان محبًّا للعلوم مكرِما لأهلها، جمّاعا للكتب في أنواعها بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله.
قال أبو محمد بن حزم (ت 456هـ/1065م): أخبرني تليد الفتى -وكان على ‘خزانة العلوم والكتب‘ بدار بني مروان (= قصر الخلافة)- أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، وفي كل فهرسة عشرون ورقة، ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير، وأقام للعلم والعلماء سوقا نافقة جلبت إليها بضائعه من كل قُطر…؛ وكان يبعث في [طلب] الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار، ويرسل إليهم الأموال لشرائها، حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه…، واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده”.
وقد نقل لنا المَقَّري التلمساني (ت 1041هـ/1631م) -في ‘نفح الطيب‘- معطيات بالغة الأهمية عن حجم خزانة كتب الأمويين هذه وكيف تكوّنت؛ فقال إن المستنصر هذا “كان محبًّا للعلوم مكرِما لأهلها، جمّاعا للكتب في أنواعها بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله.
قال أبو محمد بن حزم (ت 456هـ/1065م): أخبرني تليد الفتى -وكان على ‘خزانة العلوم والكتب‘ بدار بني مروان (= قصر الخلافة)- أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، وفي كل فهرسة عشرون ورقة، ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير، وأقام للعلم والعلماء سوقا نافقة جلبت إليها بضائعه من كل قُطر…؛ وكان يبعث في [طلب] الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار، ويرسل إليهم الأموال لشرائها، حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه…، واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده”.
وكذلك ما يذكره ابن أبي أصَيْبِعة (ت 668هـ/1269م) -في ‘عيون الأنباء‘- نقلا عن الفيلسوف والطبيب ابن سينا (ت 428هـ/1038م) في وصف خزانة كتب سلطان بخارى نوح بن منصور الساماني (ت 387هـ/998م)؛ فيقول -واصفا ضخامتها ودقة تصنيف وترتيب كتبها- إن السلطان مرض مرة “فأجْرَوْا ذكري بين يديه وسألوه إحضاري، فحضرت وشاركتهم في مداواته، وتوسمت خدمته فسألته يوما الإذن لي في دخول دار كتبهم ومطالعتها..، فأذن لي فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة، في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض، وفي بيت فيها كتبُ العربية والشعر، وفي آخر الفقه، وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد، فطالعت فهرست كتب الأوائل..، ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قطّ، وما كنت رأيته من قبل، ولا رأيته من بعد”.
وعن خزائن كتب معاصره السلطان البُوَيْهي عَضُد الدولة (ت 372هـ/984م) ومرافقها وحسن تنظيمها ودقة إدارتها؛ يقول المقدسي البشاري (ت 380هـ/991م) في كتابه ‘أحسن التقاسيم‘: “وبنى بشيراز دارا لم أرَ في شرق ولا غرب مثلها…، وسمعت رئيس الفراشين يقول: فيها ثلاثمئة وستون حجرة…، وخزانة الكتب على حدة، وعليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد. ولم يبق كتاب صنّف إلى وقته من أنواع العلوم كلها إلا وحصله فيها”.
وجاهة سلطانية
وقد اقتدى بهؤلاء السلاطين وزراؤُهم وكتّابهم فسعوا مثلهم لرسم صورة زاهية عنهم في عيون الناس وخاصة العلماء؛ فكان مثلا للوزير البويهي الكبير الفضل بن العَميد (ت 360هـ/972م) خزانة كتب كبيرة أسند إدارتها إلى الفيلسوف المؤرخ أبي علي مِسْكَوَيْه الرازي (ت 421هـ/1031م)، فصديقه أبو حيان التوحيدي (ت بعد 400هـ/1010م) يخبرنا -في كتابه ‘أخلاق الوزيرين‘ أو ‘مثالب الوزيرين‘- بأن ابن العميد قرّب مِسْكَوَيْه إلى درجة أنه “اتخذه خازناً لكتبه” وجعله مؤدِّبا لولده.
بل إن مِسْكَوَيْه نفسه يصرح -في ‘تجارب الأمم‘- بتوليه أمانة تلك المكتبة، ويصف لنا ضخامة محتوياتها وتنوعها، وذلك في معرض حديثه عن تعرضها للاعتداء؛ فقال: “واشتغل (الجنود) الخراسانية بنهب داره واصطبلاته وخزائنه..، وكان إليَّ خزائن كتبه فسلِمت من بين خزائنه ولم يُتعرض لها…، واشتغل قلبه بدفاتره (= كتبه) ولم يكن شيء أعز عليه منها، وكانت كثيرة فيها كل علم، وكل نوع من أنواع الحكمة والأدب، تُحمل على مئة وِقْرٍ (= حِمْل دابة) وزيادة”.
وجريا في هذا المضمار؛ أسّس الوزير البويهي الصاحب ابن عَبَّاد (ت 385هـ/996م) مكتبة ضخمة قال عنها بنفسه وفق ما يرويه الحموي في ‘معجم الأدباء‘: “اشتملت خزائني على مئتين وستة آلاف مجلد”.
ويضيف الحموي أن الملك نوح الساماني “أرسل إلى الصاحب [ابن عباد] في السر يستدعيه إلى حضرته ويرغّبه في خدمته..، فكان من جملة اعتذاره [له] أن قال: كيف يحسن بي مفارقة قوم بهم ارتفع قدري، وشاع بين الأنام ذكري، ثم كيف لي بحمل أموالي مع كثرة أثقالي، وعندي من كتب العلم خاصة ما يُحمل على أربعمئة جمل أو أكثر”!! ولعل مكتبة ابن عباد هذه هي التي قصدها الحموي حين تحدث عن مخطوطة بمدينة الريّ (= طهران اليوم) رآها أحدهم في “دار كتبها التي وقفها الصاحب ابن عباد”.
وفي الأندلس تغالى عِلّية الناس في تكوين المكتبات الشخصية وبالغوا في تميّز محتوياتها وجودة مخطوطاتها؛ فها هو المقري يصف لنا العاصمة قرطبة فيقول إنها “أكثر بلاد الأندلس كتبا و[أهلها] أشد الناس اعتناء بخزائن الكتب، صار ذلك عندهم من آلات التعيّن (= الوجاهة الاجتماعية) والرياسة، حتى إن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب، وينتخب فيها ليس إلا لأن يقال: فلان عنده خزانة كتب! والكتاب الفلاني ليس هو عند أحد غيره! والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصّله وظفر به”!!
ومن نماذج كتّاب السلاطين ذوي المكتبات الكبيرة؛ ما أورده الإمام ابن كثير (ت 774هـ/1371م) -في ‘البداية والنهاية‘- من أنّ الفاضل البَيْسَاني كاتب السلطان صلاح الدين (ت 589هـ/1193م): “قد اقتنى… من الكتب نحواً من مئة ألف كتاب، وهذا شيء لم يفرح به أحدٌ من الوزراء ولا العلماء ولا الملوك ولا الكتّاب” في عهده!
ويقول القلقشندي إنه حين أطاح صلاح الدين بحكم الفاطميين عُرضت مكتبتهم للبيع “فاشترى القاضي الفاضل أكثر كتب هذه الخزانة، ووقفها بمدرسته الفاضلية بدرب ملوخيا بالقاهرة، فبقيت فيها إلى أن استولت عليها الأيدي فلم يبق منها إلا القليل”.
وكذلك الأديب بهاء الدين زهير الأزْدي (ت 656هـ/1258م) وكان كاتبا لسلطان مصر الصالح أيوب (ت 647هـ/1249م)؛ فقد زار بيتَه الأديبُ علي بن سعيد المغربي (ت 685هـ/1284م) فقال عن مكتبته وفق ما أورده الصفدي (ت 764هـ/1363م) في ‘الوافي بالوفيات‘: “وصلتُ إلى ميعاده فوجدته بخزانة كتبه، فكانت أول خزانة ملوكية رأيتها لأنها تحتوي على خمسة آلاف سفر ونيف”!!
وبعد عهود زاهرة بالعطاء المعرفي؛ كمُنت الحضارة الإسلامية نتيجة انشغال الناس عن تحصيل العلم، وضعف حرصهم على بذل الغالي والنفيس من أجل الكتب. وتوازى ذلك مع تحول الملوك والأمراء من محبين للقراءة وخزائن الكتب إلى مراحل من الملك الجبري غير المستند على أي من أنواع المعرفة. يقول القلقشندي -في ‘صبح الأعشَى في صناعة الإنشا’- بعد أن ذكر مكتبات العالم الإسلامي الثلاث الكبرى: “أما الآن فقد قلّت عناية الملوك بخزائن الكتب، اكتفاءً بخزائن كتب المدارس التي ابتنوها من حيث إنها بذلك أمسّ”.
فلم يعد السلاطين يُعْنَوْن بتقريب الفلاسفة والعلماء والأدباء كما كانوا سابقا، وذلك لأسبابٍ كثيرة متعلقة بما هو داخل الجماعة العلمية، وما هو داخل إدارة الدولة، وأخرى متعلقة بالخارج وتعرض دولة الإسلام لهجماتٍ مميتة من الشرق والغرب كادت أن تودي بالإسلام كلّه، ثمّ حدث التحول العميق إثر نشوء الدولة الحديثة فتبدلت مناطات تعزيز شرعية الحاكم، وقاد ذلك إلى تغيّر شديد في ثقافة العلماء وثقافة الأمراء والعلاقة بين الطرفين!!
تقليد علمائي
جاء اقتناء الفقهاء والعلماء للكتب تأسِّياً بالبذرة التي بذرها الصحابة والتابعون في هذا الشأن، إذ كانت لكلّ صحابي صحائف وكتب خاصة به، وربما كتب فيها أحاديث عن النبي ﷺ.
ويروي المؤرخ ابن سعد (ت 230هـ/845م) -في ‘الطبقات الكبرى‘- عن عروة بن الزبير تحسّره على ما أحرِق له من كتب في معركة الحَرَّة سنة 63هـ/684م، فقال: “لأن تكون عندي أحبّ إليّ من أن يكون لي مثل أهلي ومالي”. وواقعة الحرة شهدها كثير من الصحابة والتابعين، ويلزم من ذلك أنّ الصحابة عرفوا الكتب وحرصوا عليها خشية انْدراس العلم.
ويذكر ابن عبد البر -في ‘جامع بيان العلم وفضله‘- قولَ الإمام يونس بن يزيد الأيْلي (ت 160هـ/778م): “قلت للزهري أخرج إليّ كتبك، فأخرج إلي كتباً فيها شعر”؛ وهو مما يعني أنّ كتبهم لم تكن دينية فقط. ويذكر النديم أنّ المؤرخ الواقديّ (ت 207هـ/822م) ترك بعد وفاته مكتبة كبيرة فيها “ستمئة قِمَطْرٍ (= وعاء للكتب) كُتُباً، كل قِمَطْر منها حِمْلُ رجلين، وكان له غلامان مملوكان يكتبان الليل والنهار، وقبل ذلك بيع له كتب بألفيْ دينار”!
ولم يكن اقتناء العلماء والفقهاء للكتب أمراً سهلاً لندرتها أول الأمر، ثم بسبب ما كانوا يعانونه غالبا من الفاقة والعوز، ومع ذلك فقد قدموا الكتب على المال والطعام والمبلس، وآثروا حياة التقشف من أجل العلم والتعلم والتعليم.
فقد نقل النووي (ت 676هـ/1267م) -في ‘تهذيب الأسماء واللغات‘- أن إمام المحدِّثين علي بن المَدِيني (ت 234هـ/848م) قال إن معاصره يحيى بن معين (ت 233هـ/848م) -وهو أيضا أحد أئمة الحديث- قال: “ما أعلم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين، وخلف والده معين ليحيى ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم (= اليوم 2.1 مليون دولار أميركي) أنفقها كلها في الحديث، حتى لم يبق له نعل يلْبَسُها”.
وفي الإنفاق على الكتب وخزائنها يقول ابن الجوزيّ (ت 597هـ/1201م) في رسالته إلى ولده: “اعلم يا ولدي أن أبي كان موسراً، وخلَّف ألوفا من المال، فلمّا بلغتُ دفعوا لي عشرين ديناراً، ودارين، وقالوا لي: هذه التركةُ كلُّها، فأخذتُ الدنانير واشتريتُ بها كتباً من كتب العلم، وبعتُ الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلمِ، ولم يبق لي شيءٌ من المالِ، وما ذَلَّ أبوك في طلب العلم قطّ”.
وجاء في ‘ذيل طبقات الحنابلة‘ لابن رجب الحنبلي (ت 795هـ/1393م) ضمن ترجمة ابن الخشاب الحنبلي (ت 567هـ/1171م) أنه “لم يمت أحد من أهل العلم وأصحاب الحديث إلا وكان يشتري كتبه كلها، فحصلَتْ أصولُ المشايخ عنده، وكان لا يخلو كُمّه من كتب العلم…؛ ولمّا مرض أُشهد بوقف كتبه فتفرقت وبيع أكثرها ولم يبق إلا عشرها، فتُركت في رباط المأمونية [ببغداد] وقفاً”.
ووصف الذهبي -في ‘تذكرة الحفاظ‘- أبا العلاء الهمذاني (ت 569هـ/1173م) بأنه “الحافظ العلامة المقرئ شيخ الإسلام…، عمل داراً للكتب وخِزانة [بمدينة همذان]، ووقَفَ جميع كتبه فيها، وكان قد حصّل الأصول الكثيرة، والكتب النادرة الكبارَ الحسان، بالخطوط المعتبَرة، وأرْبى على أهل زمانه في كثرة السماعات، مع تحصيل أصول ما سَمِعَ، وجودة النُّسخ وإتقان ما كتبه بخطّه، فإنّه ما كان يكتب شيئا إلا منقَّطاً مُعْرَباً”.
ثم تطور اهتمام العلماء بتكوين مكتباتهم الشخصية وبذلهم نفائس ما يملكونه في ذلك، حتى صار حجم بعضها يقارن بمكتبات الوزراء والأمراء بل والملوك، فكانوا يصفون العالم بأنه صاحب “خزانة ملوكية” إذا بلغ عدد كتبه خمسة آلاف؛ كما يُفهم من رواية ابن سعيد المغربي المتقدمة. ومنهم الفقيه أحمد ابن الذويد الصَّعْدي اليمني (ت 1020هـ/1611م) الذي “اجتمع له من الكتب خزانة ملوكية”؛ كما يقول ابن زبارة الصنعاني (ت 1381هـ/1961م) في كتابه ‘الملحق التابع‘.
مكتبات وقفية
تتنوع المكتبات إلى خاصة وعامة، وأخرى وقفية تكون عادة في المساجد والزوايا والمدارس ونحو ذلك؛ فمن أمثلة المكتبات الخاصة ما ذكرناه عن المكتبات العلمائية والسلطانية، إضافة إلى المكتبات التي كانت تزود بها قصور الأمراء والسلاطين، وهناك المكتبات العامّة المفتوحة أمام الجمهور.
ومن الأمثلة المبكرة للأخيرة مكتبة عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي التي أنشأها -في نهاية القرن الأول الهجري- بمكة المكرمة قرب الحرم، وكانت أشبه بناد ثقافي متعدد الأنشطة ذُكر لنا من رواده الشاعر الأحْوَص الأنصاري (ت 105هـ/724م).
وجاء عند المؤرخ القرشي الزبير بن بكار (ت 256هـ/870م) -في كتابه ‘جمهرة نسب قريش وأخبارها‘- أن الجمحي هذا “اتّخذ بيتا فيه شترنجات (= شطرنج) ونَرْدات (= لعبة الطاولة) وقِرْقات (= ألعاب أطفال)، ودفاتر فيها من كل علم، وجعل في الجدار أوتادا فمن جاءه علق ثيابه على وتد منها، ثم جرّ دفتراً فقرأه، أو بعض ما يُلعب به فيلعب مع بعضهم”.
وكانت ثمة مكتبات عامة ملحقة بالمساجد، وبأبنية المدارس العلمية والمستشفيات، وزوايا الصوفية ونحوها؛ ومن هذا القبيل ما يحكيه ياقوت الحموي -في ‘معجم البلدان‘- عن خزائن كتب مساجد مَرْوَ بخراسان، التي يجعلها من أسباب حبه لتلك البلاد وعزمه المكوث فيها لولا غزو التتار لمدنها؛ فيقول:
“ولولا ما عرا من ورود التتر (= التتار) إلى تلك البلاد وخرابها لما فارقتها إلى الممات، لما في أهلها من الرِّفد ولين الجانب وحسن العشرة، وكثرة كتب الأصول المتقنة بها، فإني فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف لم أرَ في الدنيا مثلها كثرة وجودة”!
ويأخذ الحموي في تعداد وتسمية هذه الخزائن مقدما لمحة عن نظام إعارة الكتب فيها، فيقول: “منها خزانتان في الجامع إحداهما يقال لها العزيزية…، وكان فيها اثنا عشر ألف مجلد أو ما يقاربها، والأخرى يقال لها الكمالية..، وبها خزانة شرف الملك المُسْتَوْفِي (ت 494هـ/1201م).. في مدرسته…، وخزانة نظام الملك الحسن بن إسحق في مدرسته، وخزانتان للسمعانيين، وخزانة أخرى في المدرسة العميدية، وخزانة لمجد الملك أحد الوزراء المتأخرين بها، والخزائن الخاتونية في مدرستها، والضميرية في خانكاه (= مدرسة صوفية) هناك”.
ثم يحدثنا عن مدى الاستفادة التي جناها من هذه المكتبات الوقفية، فيقول إن كتبها “كانت سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مئتا مجلّد وأكثر بغير رهن، تكون قيمتها مئتيْ دينار؛ فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها، وأنساني حبها كل بلد وألهاني عن الأهل والولد، وأكثر فوائد هذا الكتاب (= ‘معجم البلدان‘) وغيره مما جمعته فهو من تلك الخزائن”.
خزائن ضخمة
ويروي ابن الجوزي أنه في سنة 515هـ/1121م شبّ حريق في جامع أصفهان وهو “جامع كبير أنفِقت الأموال في العمارة له، وكان فيه من المصاحف الثمينة نحو خمسمئة مصحف، من جملتها مصحف ذُكر أنه بخط أُبَيِّ بن كعب” (ت 30هـ/752م) رضي الله عنه.
ويذكر ابن عساكر (ت 571هـ/1175م) -في ‘تاريخ دمشق‘- أن زميله في الرحلة لطلب العلم أبا بكر ابن ياسر الجَيّاني الأندلسي (ت 566هـ/1171م) لما جاء إلى حلب “سُلّمت إليه ‘خزانة الكتب النُّورية‘ بها فأجرِي عليه جراية (= راتب شهري)…، ووقف كتبه على أصحاب الحديث”.
وينقل المقري عن ابن سعيد المغربي وصفه ‘المدرسة العادلية‘ التي بناها السلطان الأيوبي العادل (ت 615هـ/1218م) في دمشق للشافعية؛ بأنها “في نهاية الحسن، وبها خزانة كتب فيها تاريخ ابن عساكر”.
وكانت في “مسجد عقيل” بنيسابور (تقع اليوم شمال شرقي إيران) مكتبة ضخمة كما هو مقتضى ما أورده ملك حماة المؤرخ أبو الفداء (ت 732هـ/1332م) في ‘المختصر في أخبار البشر‘، قال: “في هذه السنة (= 556هـ/1171م) تقدم المؤيد أيْ بَهْ (السِّجْزي المتوفى 568هـ/1172م) بإمساك أعيان نيسابور لأنهم كانوا رؤساء للحرامية والمفسدين..، فخربت نيسابور وكان من جملة ما خرب مسجد عقيل، وكان مجمعاً لأهل العلم، وكان فيه خزائن الكتب الموقوفة، وخرب من مدارس الحنفية سبع عشرة مدرسة، وأحرق ونهب عدة من خزائن الكتب”.
وضمن المكتبات الضخمة التي بناها السلاطين ملحقةً بمدارس العلم التي كانوا ينشئونها؛ يأتي النموذج البارز ممثلا بالمدرسة المستنصرية ببغداد التي بناها الخليفة العباسي المستنصر (ت 640هـ/1242م)، وافتتحها سنة 631هـ/1234م. ويصف ابن الفُوَطي الشَّيباني (ت 723هـ/1323م) -في كتابه ‘الحوادث الجامعة‘- مكتبة المستنصرية قائلا:
“نُقل.. إلى المدرسة من الرَّبعات الشريفة والكتب النفيسة -المحتوية على العلوم الدينية والأدبية- ما حَمَله مئة وستون حمالا، وجُعلت في خزانة الكتب، وتقدم إلى.. ضياء الدين أحمد [ابن عبد العزيز بن دلف البغدادي (ت 640هـ/1242م)] -الخازن بخزانة كتب الخليفة التي في داره-.. فحضر.. ورتبها أحسن ترتيب مفصِّلا لفنونها ليَسْهُل تناولُها ولا يتعب مُناولُها…، ثم خلع على… المعينين للخدمة بخزانة الكتب، وهم الشمس علي بن الكتبي (ت 656هـ/1258م) الخازن”.
“نُقل.. إلى المدرسة من الرَّبعات الشريفة والكتب النفيسة -المحتوية على العلوم الدينية والأدبية- ما حَمَله مئة وستون حمالا، وجُعلت في خزانة الكتب، وتقدم إلى.. ضياء الدين أحمد [ابن عبد العزيز بن دلف البغدادي (ت 640هـ/1242م)] -الخازن بخزانة كتب الخليفة التي في داره-.. فحضر.. ورتبها أحسن ترتيب مفصِّلا لفنونها ليَسْهُل تناولُها ولا يتعب مُناولُها…، ثم خلع على… المعينين للخدمة بخزانة الكتب، وهم الشمس علي بن الكتبي (ت 656هـ/1258م) الخازن”.
وعن طريقة تصفح الكتب وضوابطه؛ يقول ابن جماعة إن المطالع “إذا نسخ من كتاب أو طالعه فلا يَضَعُهُ على الأرض مفروشاً منشوراً، بل يجعله بين كتابين أو شيئين، أو كرسي الكُتُب المعروفِ، كيلا يسرع تقطيع حبكه”.
وقد رجّح العلماء جواز استعارة الكتب وإعارتها وبينوا آداب الاستعارة وضوابط الإعارة؛ فقال ابن جماعة: “وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة. بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك. ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشِّيه (= يكتب في هوامشه)”. وعن احترام الكتاب يقول: “ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس (= ملزمات الأوراق: الكراسة 10 ورقات تقريبا) أو غيرها، ولا مخدة ولا مروحة.. ولا مُسْتَندا ولا مُتَّكَئأً”.
أمناء علماء
وكما رأينا سابقا؛ فإنه على الأقل منذ عصر الرشيد العباسي ظهرت وظيفة “خازن الكتب” أو مدير المكتبة بمصطلحنا اليوم، وكان من ضمن وظائفه الإشراف على وضع فهرسة دقيقة لكتبها، وترتيبها وتصنيفها وتعهدها بالصيانة، وقد ذكرنا فيما سبق أسماء شخصيات بارزة تولت وظيفة “خازن الكتب” في أهم مكتبات الحواضر الإسلامية.
ونضيف إليهم هنا المحدّث أبا صالح النيسابوري (ت 470هـ/1077م) الذي وصف ياقوت الحموي -في ‘معجم الأدباء‘- مهامه ووظيفته بقوله: “الحافظ الأمين.. كان عليه الاعتماد في الودائع من كتب الحديث المجموعة في الخزائن الموروثة عن المشايخ، الموقوفة على أصحاب الحديث، وكان يصونها ويتعهّد حفظها ويتولّى أوقاف المحدثين من الحبر والكاغد وغير ذلك، ويقوم بتفرقتها عليهم وإيصالها إليهم”.
وتُمدنا كتب التاريخ والتراجم بالعشرات من أسماء أمناء بعض المكتبات العامة في الحواضر الإسلامية الكبرى، وخاصة تلك التي كانت ملحقة بالمدارس الكبيرة التي شاع تأسيسها منذ القرن الخامس الهجري/الـ11م، بل إن بعض هذه المصادر يتحفنا أحيانا بأسماء أوائل من تولوا تلك الوظيفة ذات المكانة السامية.
فالجغرافي الفقيه زكرياء بن محمد القَزْوِيني (ت 682هـ/1281م) يفيدنا -في كتابه ‘آثار البلاد وأخبار العباد‘- بأن إمام الأدب واللغة أبا زكرياء التَّبْرِيزي (ت 502هـ/1108م) كان أول من تولى أمانة مكتبة المدرسة التي بناها الوزير السلجوقي نِظام الملك (ت 485هـ/1092م) في بغداد، وعُرفت تاريخيا باسم “المدرسة النِّظامية”؛ فقد ذكر أن التبريزي “كان أديبا فاضلا كثير التصانيف، فلما بنى نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد جعلوا أبا زكرياء خازن خزانة الكتب”.
وسبق ما نقلناه عن ابن الفُوَطي من أن شمس الدين علي بن الكُتبي (ت 656هـ/1258م) كان أول مدير لمكتبة مدرسة المستنصرية العظيمة، والتي لم تلبث سوى ربع قرن -بعد افتتاحها- حتى دمرها المغول باجتياحهم بغداد سنة 656هـ/1258م. كما تولى الوظيفة نفسها تاج الدين ابن الساعي البغدادي (ت 674هـ/1273م) الذي وصفه الصفدي بأنه “المؤرخُ خازنُ [كُتُب المدرسة] المستنصرية” ببغداد التي تقدم الحديث عنها.
والملاحظُ أنّ كافة من تولوا منصب “خازن دار الكتب” -أو “خازن دار العلم” أو “خازن خزانة الكتب”- كانوا من العلماء العارفين بمختلف العلوم؛ فكان مثلا أبو صالح النيسابوري محدثا كبيرا، وكذلك أبو يوسف الخازن الإسفراييني (ت 488هـ/1095م) الذي يصفه ابن شاكر الكُتبي (ت 764هـ/1362م) -في ‘فوات الوفيات‘- بقوله: “كان خازن الكتب بالنظامية (= المدرسة النظامية ببغداد)، وهو فقيه فاضل حسن المعرفة بالأصول (= العقائد)..، وله معرفة بالأدب، وكان يكتب خطا جيدا”.
وقد تكلم الفقهاء على وظيفة “خازن الكتب” هذه فبينوا واجباتها وآدابها؛ فيقول التاج السبكي: “وحقٌّ عليه (= الخازن) الاحتفاظ بها وترميم شعثها، وحبكُها عند احتياجها للحبك، والضِّنّة بها على من ليس من أهلها، وبذلها للمحتاج إليها، وأن يقدم في العارية الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء”. وتفيدنا المصادر بأن هؤلاء الخزنة كانوا يستخدمون “دواء البراغيث” لصيانة الكتب وترميمها إذا “هلكت الكتب.. بالبراغيث وعيثهم فيها وعبثهم بها”؛ كما نجد في حكاية طريفة أوردها الصابئ (ت 480هـ/1187م) في ‘الهفوات النادرة‘.
تحريق وتغريق
وعلى المستوى المكتبات الشخصية؛ كان أكثر ما كان يشغل العالم بعد موته هو كتبه، فيخشى أن تقع في أيدي من لا يعرف قيمتها، علاوة على ألم الفقد في ذاته، ولذا فقد لجأ كثير من العلماء إلى وقف كتبهم بعد موتهم أو حتى في حياتهم. وقد تكررت كثيراً في كتب تراجم العلماء عبارة أن فلانا “وَقَفَ كُتبَه” ونحوها، مما يعني أن ذلك كان ثقافة شائعة لدى العلماء في تلك العصور، كما يشير إلى أهمية دَوْر الوقف في تشكّل خزائن الكتب عبر التاريخ الإسلامي.
فهذا الإمام المحدّث ابن حِبّان البُسْتي (ت 354هـ/965م) وضع “خزانة كتبه في يديْ وصيٍّ سلّمها إليه، ليبذلها لمن يريد نسخ شيء منها.. من غير أن يخرجه” من دار المكتبة؛ حسب ما جاء في ‘معجم البلدان‘ لياقوت الحموي الذي يخبرنا أيضا -في ‘معجم الأدباء‘- بأن اللغوي الفقيه محمد بن عبد الرحمن البَنْدَهي الشافعي (ت 584هـ/1188م) “أقبلت عليه الدنيا فحصّل كتبا لم تحصل لغيره ووقفها بخانقاه السُّمَيْساطي” بدمشق.
ويفيدنا ابن سبط الجوزي (ت 654هـ/1256م) -في ‘مرآة الزمان‘- بأن الطبيب يحيى ابن جَزْلَة البغدادي (ت 473هـ/1080م) “وقف كتبه قبل وفاته وجعلها في مشهد أبي حنيفة (إمام المذهب الفقهي المعروف ت 150هـ/768م)”. وكان ابن جزلة هذا مسيحيا ثم أسلم.
وترجم السمعاني (ت 562هـ/1167م) -في كتابه ‘الأنساب‘- لأبي المعالي الرشيدي (توفي أوائل القرن السادس الهجري/الـ12م) فقال إنه “وقف كتبه في الجامع المَنيعى [بنيسابور]، واحترق جميع كتبه في الخزانة التي في الجامع في فتنة الغُزِّ (= قبائل تركية)” الأولى سنة 548هـ/1153م. وهو ما يعني وجود خزائن كتب عامّة بهذا الجامع العظيم الشهير، الذي بناه التاجر الكبير أبو علي المَنيعي المخزومي (ت 463هـ/1071م)، وكان من خطبائه الإمام الجويني (ت 478هـ/1085م).
وقام رشيد الدين الوطواط (ت 573هـ/1177م) بوقف ألف مجلد على خزائن الكتب، وقال في رسالة له حسبما نقله الحموي في ‘معجم الأدباء‘: “وها أنذا قد أتاني الله من الوجه الحلال قريبا من ألف مجلد من الكتب النفيسة، والدفاتر الفائقة، والنسخ الشريفة، ووقفت كلها على خزائن الكتب المبنية في بلاد الإسلام -عمرها الله- لينتفع المسلمون بها”. وفي ترجمة الخليفة العباسي المستنصر لدى ابن كثير -في ‘البداية والنهاية‘- قال إنه “وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة…، ووقف فيها كتبا نفيسة ليس في الدنيا لها نظير”.
وبعضهم بيعت كتبه بعد موته؛ فقد ترجم ابن حجر (ت 852هـ/1448م) -في ‘الدرر الكامنة‘- لابن القيم (ت 751هـ/1350م) وقال إنه “كان مُغْرًى بجمع الكتب فحصّل منها ما لا يُحصر، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً، سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم”. وبعضهم باع كتبه بسبب فقره، وكان هذا أشدّ على نفسه من فقده أحبابه وخِلّانه.
وبعضهم أحرق كتبه بنفسه نزوعا إلى الزهد والعزلة للتعبد أو احتجاجا على إهمال المجتمع إياه وخذلانه له. ولعل من أقدم نماذج الفريق الأول مثال الإمام اللغوي أبو عمرو بن العلاء البصري (ت 158هـ/776م) الذي يقول الجاحظ عنه (ت 255هـ/869م) -في ‘البيان والتبيين‘- إنه “كانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف، ثم إنه تقرّأ (= تزهّد) فأحرقها كلها؛ فلمّا رجع بعدُ إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه”.
إتلاف عقابي
ومن أمثلة الفريق الثاني الفقيه الشافعي والأديب الكبير أبو حيان التوحيدي (ت بعد 400هـ/1010م) الذي يقول عارضا أسباب حرقه للكتب بعبارة حزينة مؤلمة: “ثمّ اعلم أنّ هذه الكتب حوت من أصناف العلم سرّه وعلانيته..، على أني جمعت أكثرها للناس…، فما صحّ لي من أحدهم ودٌّ…؛ فها قد أصبحتُ في عشر التسعين وهل لي بعد الكبر والعجز أملٌ في حياة لذيذة؟”. ثم يخبرنا بأن حرق الكتب ظاهرة معروفة بين العلماء، فيقول: “ولي في إحراق الكتب أسوة بأئمة يُقتدى بهم ويؤخذ بهديهم”!!
وبعضهم احترقت كتبه كُرهاً؛ فقد قال الذهبيّ (ت 748هـ/1347م) -في ‘تذكرة الحفّاظ‘- إنّ قاضي مصر ومُحدّثها عبد الله بن لَهِيعة (ت 174هـ/790م) احترقت كتبه سنة 169هـ/785م فكثُر الوهم في حديثه. وفي ترجمة الإمام الخِرَقي الحنبلي (ت 334هـ/945م) من ‘البداية والنهاية‘ لابن كثير: “وكان الخِرَقي هذا من سادات الفقهاء والعبّاد..، خرج من بغداد مهاجرًا لما كثر بها الشر والسبُّ للصحابة، وأودع كتبه في بغداد فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب، وعُدمت مصنفاته”.
وجاء في ‘معجم الأدباء‘ للحموي ضمن ترجمة أبي عليّ الفارسيّ (ت 377هـ/988م): “قال عثمان بن جِنّي (ت 392هـ/1003م): حدثني شيخنا أبو عليّ أنه وقع حريق بمدينة السلام (= بغداد) فذهب به جميع علم البصريين…، وسألته عن سلوته وعزائه، فنظر إليّ عاجباً ثم قال: بقيت شهرين لا أكلّم أحداً حُزناً وهمّا”!!
وذكر المقريزي (ت 845هـ/1441م) -في ‘المواعظ والاعتبار‘- أنه في سنة 691هـ/1292م وقع حريق في خزانة الكتب بقلعة الجبل في القاهرة “فأتلف بها من الكتب -في الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم- شيء كثير جدًّا كان من ذخائر الملوك، فانتهبها الغلمان وبيعت أوراقًا محرقة، ظفر الناس منها بنفائسَ غريبةٍ ما بين ملاحمَ وغيرها، وأخذوها بأبخس الأثمان”.
وبعضهم غرقت كتبه؛ قال ابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) في ‘المنتظم‘: “لما وقع الغرق سنة أربع وخمسين وخمسمئة غرقتْ كتُبي، وسَلِم لي مجلَّد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد” بن حنبل (ت 241هـ/855م).
ومن طرائف إتلاف الكتب بالغرق ما أورده ابن أبي أصَيْبِعة من أن الأمير أبا الوفاء المُبشِّر بن فاتِك (ت 500هـ/1106م) كان “محبا لتحصيل العلوم وكانت له خزائن كتب، فكان في أكثر أوقاته إذا نزل من الركوب لا يفارقها وليس له دأب إلا المطالعة والكتابة، ويرى أن ذلك أهم ما عنده. وكانت لهذا الأمير زوجة كبيرة القدر أيضا من أرباب الدولة، فلما توفي -رحمه الله- نهضت هي وجوارٍ معها إلى خزائن كتبه -وفي قلبها [غِيرة] من الكتب وأنه كان يشتغل بها عنها- فجعلت تندبه، وفي أثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء كبيرة في وسط الدار هي وجواريها، ثم شيلت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق أكثرها”.
وهناك أحداث سياسية -كحروب الغزو الأجنبي وفتن الاقتتال الداخلي ونكبات الأنظمة الحاكمة لمن تسخط عليهم سياسيا أو فكريا- أدت إلى إفناء الكتب بالحرق أو الغرق ونحوهما. وقد أشار القلقشندي إلى هذه الأسباب حين ذكر مصير المكتبات الثلاث الكبرى بالحضارة الإسلامية؛ فقال إن مكتبة الفاطميين “لم تزل.. إلى أن انقرضت دولتهم بموت.. آخر خلفائهم، واستيلاء السلطان صلاح الدين.. على المملكة”؛ وكذلك خزانة الأمويين بالأندلس “لم تزل إلى انقراض دولتهم باستيلاء ملوك الطوائف على الأندلس، فذهبت كتبها كلَّ مذهب”؛ وأما مكتبة العباسيين فظلت قائمة “إلى أن دهمت التتر بغداد.. فذهبت خزانة الكتب فيما ذهب”.
وذكر ابن الأثير (ت 630هـ/1233م) -في ‘الكامل‘- أنه في أحداث سنة 555هـ/1160م “قُبض على القاضي ابن المرخم.. وأخذت كتبه فأحرِق منها في الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة”. وعن حرق المغول لخزائن كتب مدينة ساوة (تبعد اليوم عن طهران نحو 140كم) سنة 619هـ/1222م؛ يقول ياقوت في ‘معجم البلدان‘: “فجاءها التتر الكفار الترك فخُبِّرتُ أنهم خربوها…، وكان بها دار كتب لم يكن في الدنيا أعظم منها، بلغني أنهم أحرقوها”!!